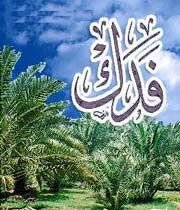فدك من الفيء والأنفال
من أبرز القضايا التي تضمنتها سيرة السيدة الزهراء(ع)، هي قضية فدك، فقد كانت أحد الأسباب للمواجهة المباشرة بينها(ع)، وبين السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، وبعيداً عن العنوان الرمزي الذي كانت ترمز إليه، فإن هناك عنواناً ظاهرياً جاءت تطالب به السيدة الزهراء(ع)، وهو كونها نحلة لها من أبيها رسول الله(ص)، ولما لم يقبل ذلك طالبت بها على أنها ميراث، وأخيراً طالبت بها على أنها سهم ذوي القربى.
وبالجملة، لقد تدرجت الصديقة الطاهرة(ع) في المطالبة بها على ثلاث مراحل طولية، فطالبت بها:
أولاً: على أنها نحلة وهبها إياها رسول الله(ص).
ثانياً: على أنها ميراث لها من أبيها النبي الأكرم محمد(ص).
ثالثها: أنها من سهم ذي القربى، الذي جعله الله تعالى إليهم.
بحيث كان لجوئها للمرحلة الثانية بعد عدم قبول القوم بالمرحلة السابقة.
وعندما يسمع أنها(ع) طالبت بفدك لأنها نحلة أعطاها إياها أبوها رسول الله(ص)، يتبادر إلى الأذهان السؤال عن كيفية حصول رسول الله(ص) عليها، وهل يسوغ له(ص) أن يعطيها إياها دون بقية المسلمين.
وينشأ الاستفهام المذكور من عدم الإحاطة بالمصادر المالية للنبي الأكرم محمد(ص)، وأنه يملك أموالاً خاصاة به، كما أن بعض الأموال العامة يحق له التصرف فيها بمقتضى ولايته عليها، ويتضح ذلك من خلال الإحاطة ولو ببعض المصادر المالية للنبي الأكرم محمد(ص).
المصادر المالية للنبي(ص):
لقد أدعى بعضهم عدم ثبوت ملكية خاصة للنبي(ص) على شيء من الأموال، وأن جميع ما تحت يده من مال فهو عائد للمسلمين، صدقة تدفع إليهم، وتقسم عليهم.
ولا يخفى أن موجب القول المذكور العمد إلى تبرير الفعل الصادر من الرجل الأول، وتصحيح مقولته: نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، حتى لو كان ذلك موجباً لمخالفة التاريخ.
وعلى أي حال، فقد تعددت الموارد المالية التي كانت تحت يده(ص)، وهي ملك شخصي له(ص)، وليس لأحد من المسلمين حق فيه، نشير لبعض مواردها:
الأول: ما وصل إليه(ص) من طريق الميراث، فقد نص المؤرخون على أنه قد ورث كلاً من: أبيه، سيدنا عبد الله، وأمه السيدة آمنة، وزوجته السيدة خديجة(ع)، وقد ذكروا ما روثه من كل واحد منهم، حيث نصوا على أنه قد ورث من أبيه: أم أيمن الحبشية، وخمسة جمال، وقطعة من غنم. وورث من أمه السيدة آمنة(ع): داراً في شعب بني علي.
وقد ورث من زوجته السيدة خديجة دارها التي في مكة بين الصفا والمروة[1].
الثاني: نصيبه الذي كان يحصل عليه من خمس الغنائم الحربية، سواء يوم بدر مثلاً، أم يوم خيبر.
الثالث: ثلث أرض وادي القرى، وحصنان من حصون خيبر وهما الوطيح، والسلالم.
الرابع: إنه(ص) لم ينقطع عن ممارسة التجارة، فقد كان يشتري ويبيع.
ومن المصادر المالية له(ص) الأنفال والفيء، فقد تضمن القرآن الكريم مفردات ثلاث، يحصل عليها المسلمون من أعداءهم خلال المعارك الحربية، وهي الأنفال والغنائم، والفيء، وقد أشير لكل واحد منها في آية من آياته[2]، فتحدث سبحان وتعالى عن الأنفال، فقال:- (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول)[3]. وقال عز من قائل متحدثاً عن الغنيمة:- (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضة من الله)[4]، ويقول تعالى عن الفيء:- (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)[5].
وما يرتبط بمحل البحث هو خصوص المفهوم الأول، أعني الأنفال، والمفهوم الثالث وهو الفيء.
معنى الأنفال والفيء:
وقد تضمنت كلمات أهل اللغة بأن الأنفال مأخوذ من النفل، وهو الزيادة، يعني زيادة الشيء.
أما في الاصطلاح الفقهي، فيقصد منه، ما جعله الله سبحانه وتعالى للمعصوم(ع) زيادة على أمواله الشخصية وزيادة على ما جعله الله تعالى له من الشركة في الخمس، إكراماً وتفضيلاً له بذلك على غيره.
ولعل جهة المناسبة بين المعنيـين اللغوي والاصطلاحي، أن تلك المأخوذات تعتبر زيادة حاصلة بالحرب.
وقد ذكرت له مصاديق متعددة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، سواء الاستدلالية، أم الفتوائية:
منها: الأرض التي حصل عليها المسلمون من دون حرب ولا قتال مع أهلها، وإنما سلمها أهلها للمسلمين، وصالحوهم عليها، سواء كان ذلك للخوف منهم، أم لسبب آخر.
ومنها: صفو المال، وقطائع الملوك، وغير ذلك مما هو مذكور في محله.
وأما الفيء، فقد فسره بعض أهل اللغة، بأنه الغنيمة[6]، وهذا يقتضي أن يكون نوعاً من أنواع الغنائم التي يحصل عليها، ليشمل كل ما يكسبه الإنسان بجهد وعناء، أو بحرب وقتال، أو بدونهما.
وقيده الراغب الأصفهاني، في المفردات، بأنه خصوص ما يُحصل عليه من دون مشقة وعناء[7]، ومن هنا اختص بما يحصل عليه المسلمون من دون حرب ولا قتال مثلاً، ليكون خاصاً بالنبي(ص)، وله مصاديق متعددة، لا تختلف عن مصاديق الأنفال، بل هي عينها، كالأراضي التي تركها أصحابها بسبب الخوف من مواجهة المسلمين، ومن أمثلته ما نقلته المصادر التاريخية من أراضي اليهود في المدينة المنورة، كأرض بني النضير وغيرها.
ملكية المعصوم(ع)للأنفال والفي:
والمستفاد من الآيات القرآنية والنصوص الشريفة أن الأنفال والفيء ملك للنبي(ص) حال وجوده في الحياة الدنيا، ومن بعده يكونا ملكاً للإمام المعصوم من بعده.
ويوجد احتمالان في ملكيتهما:
الأول: أن تكون ملكيتهما لهما ملكية شخصية، فيعاملا معاملة بقية أموالهما وممتلكاتهما بحيث تكون بعد وافتهما ميراثاً يقسم بين كافة الورثة وفق الفريضة الشرعية. وربما برر منشأ مطالبة السيدة الزهراء(ع) بفدك على أنها ميراث بعدما منعت منها نحلة، من هذا الباب[8].
الثاني: أن لا تكون الملكية للأنفال والفيء مليكة شخصية، وإنما تكون ملكية منصبية، أي بلحاظ منصب النبوة للنبي الأكرم محمد(ص) ومنصب الإمامة للإمام المعصوم(ع). فلا يتعامل معهما معاملة الملك الشخصبي الذي ينتقل لورثته بعد موته، وإنما ينتقل المال من بعد موت من كان تحت يده إلى المعصوم الذي بعده، نظير ما يكون في الخمس، فينتقل جميع ما كان تحت يد النبي(ص) إلى مولانا أمير المؤمنين(ع)، وهكذا منه لسيدنا أبي محمد الحسن(ع)، ومنه للمولى أبي عبد الله الحسين(ع)، حتى تصل اليوم إلى ولي النعمة الإمام صاحب الأمر(روحي لتراب حافر جواده الفداء).
ومع أن كلا الاحتمالين متصوراً، وقد يقام الدليل عليه، بل قد يظهر من الآيات القرآنية المتعرضة للحديث عنهما، وعن ثبوت ملكيتهما للنبي(ص) بل ربما يظهر القائل به من الأعلام.
إلا أن المشهور والمعروف بينهم، هو الثاني، أعني أنه ملك للمنصب وليس ملكاً شخصياً، ويساعد عليه النصوص، كصحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله(ع) قال: الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله(ص)، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء[9]. فإن قوله(ع): وهو للإمام من بعده، يمنع كونه ملكاً شخصياً، ويثبت أنه ملك منصب، لأن أمير المؤمنين(ع) لم يكن وارثاً لرسول الله(ص).
ولما كانت الأنفال والفيء ملكاً لمنصب النبوة حال وجود رسول الله(ص) في عالم الدنيا، ولمنصب الإمامة من بعد رحلته عنها، فللمعصوم(ع) الولاية عليها، وله أن يتصرف فيها بما يشاء، كما له أن يأذن بالتصرف فيها لمن يشاء، بل له تملكها لنفسه الشريفة، فيخص نفسه بها دون غيره من المسلمين، وله أيضاً أن يملكها من يشاء من المسلمين، كل ذلك حسب نظره الشريف، وفق المصالح العامة للإسلام وأهله.
ولو صدر من المعصوم(ع) تصرف في شيء من الأنفال والفيء حال حياته، كما لو قام بتمليك شيء منهما لشخص في حياته، لم يجز لمن جاء بعده أن يأخذ ذلك منه.
الملكيات في الشريعة الإسلامية:
ومقتضى ثبوت هذا النوع من الملكية، يجعل الملكيات الموجودة في الشريعة الإسلامية أنواعاً ثلاثة:
الأول: الملكية الشخصية، ويقصد منها ملكية كل شخص على وجه الأرض للأشياء الخاصة به ملكية شخصية، فيملك الإنسان الأموال والعقار، والأنعام، وما شابه ذلك.
الثاني: الملكية العامة للمسلمين، وهي التي يشترك المسلمون فيها جميعاً، فلا يختص بها أحد منهم دون البقية، وذلك كالأراضي الخراجية التي فتحها المسلمون عنوة، ونتيجة حرب وقتال.
الثالث: ملكية المنصب، أو قل ملكية الدولة، وهي الأموال التي تكون ملكاً لمنصب الحاكم والسلطان، وقد عرفت أن منها الأنفال والفيء، تكون ملكاً للمعصوم بما هو حاكم وسلطان على الدولة، يصرف منها على شخصه الكريم(ع)، كما يصرفها في شؤون المسلمين، الذين خصص ذلك مصرفاً لهم[10].
وقد يعترض على ما ذكر من ملكية المعصوم(ع) للأنفال والفيء ملكية منصب يتصرف فيهما كيفما يشاء، بكونه مخالفاً لظاهر القرآن الكريم، حيث يقول تعالى:- (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)[11]، لأن المستفاد منها أن الفيء يقسم بين الفئات المستحقة كما تقسم الغنيمة، وليس ملكاً خاصاً للمعصوم(ع).
ويتضح جواب ذلك بملاحظة ثلاثة أمور:
أولها: تحديد المقصود من الفيء في الآية المباركة:
فإنه قد وقع الخلاف بين المفسرين في ذلك على قولين، فأختار جماعة منهم أنه متحد مع الفيء المذكور في الآية السابقة عليها، وليس مغايراً له، بما هما مفهوم واحد. وأختار آخرون المغايرة بينهما، فيكون المقصود من الفيء في هذه الآية شيئاً آخر غير المقصود منه في الآية السابقة.
وقد اختلف أصحاب القول الثاني على فريقين، فأختار بعضهم أن المقصود به هو الجزية والخراج الذي يحصل عليهما المسلمون عن طريق الضريبة المفروضة على أهل الكتاب.
وقال آخرون بأن المقصود منه هو مطلق الغنيمة.
ولا يخفى أنه لو بني على القول الثاني بقسميه، لن يكون للاعتراض المذكور مجال أصلاً للمغايرة بين المفردتين مفهوماً، وبالتالي يتغير الحكم المرتبط بكل منهما.
ويساعد على هذا القول، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) قال: سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول، وأما قوله:- (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)، قال: ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله:- (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فهذا بمنـزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول، وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي[12]. فإنه صريح في أن الفيء في الآية الثانية مغاير للفيء في الآية الأولى. وعليه سوف يكون المقصود منه ما أخذ من أهل القرى بالقتال وبعد الغلبة والدخول عليهم في قراهم.
إنما يأتي الإشكال حال البناء على القول الأول، وأن المفردتين تشيران لحقيقة واحدة، وهذا ما سيتضح جوابه من خلال ملاحظة الأمر الثاني.
ثانيها: نوعية المصرف:
ثم إنه بعد التسليم بإعطاء الأصناف التي تضمنتها الآية الشريفة، يقع البحث في أن الإعطاء المذكور لها على نحو الاستحقاق والملك، بحيث يمكنها المطالبة به حال المنع، بل والتقاضي للمطالبة به. أم أنه على نحو المصرف، فإن أعطوا وإلا فليس لهم حق يطالبون به، وهذا يعني أن الإعطاء أقرب ما يكون للتفضل.
ومقتضى التأمل في الآية الشريفة، بعيداً عن النصوص، بل هو مقتضاها أيضاً يفيد أن ذلك بنحو المصرف والتفضل، وليس بنحو الاستحقاق، ويظهر هذا من وجود لام الملكية في الأصناف الثلاثة، وهم الله سبحانه وتعالى، والرسول، وذي القربى، دون الأصناف الثلاثة الباقية.
ووفقاً لذلك لن يكون بين هذه الآية الشريفة، لو بني على أن المقصود بالفيء فيها هو عين الفيء الموجود في الآية السابقة منافاة، لأن ما تضمنته يشير لقيام ولي الأمر بالصرف للفيء والأنفال على هؤلاء من المسلمين، وهذا لا يعني عدم اختصاص المنصب به، ولا يعني عدم امكانه أن يتملكه لنفسه.
ثالثها: من هم الأصناف:
وبقي بعد ذلك تحديد المقصودين بالأصناف الثلاثة التي تضمنتهم الآية الشريفة، فهل هم من عامة المسلمين، أم أنهم من خصوص بني هاشم، فلا يعطى إلا اليتيم الهاشمي، والمسكين الهاشمي، وابن السبيل الهاشمي؟ احتمالان، بل قولان بين المفسرين والفقهاء. والذي تساعد عليه الأدلة هو الثاني، وتفصيل ذلك بصورة مفصلة يطلب من البحوث التفسيرية والفقهية.
فدك فيء ونفل:
ومن أجلى مصاديق الفيء والأنفال قرية فدك، وهي قرية بالحجاز تبعد عن المدينة المنورة مسيرة يومين، وقيل ثلاثة أيام، وفيها عين فوارة، ونخيل كثيرة. وقد كان يبلغ خراجها ما بين 24000 إلى 70000 دينار سنوياً، وهو مبلغ كبير جداً في تلك الأيام، وهذا يكشف عن السبب الموجب لمصادرتها وأخذها من يد الصديقة الطاهرة(ع).
وقصتها، أن رسول الله(ص) بعد فراغه من معركة خيبر بقيت بقية من أهلها، فتحصنوا في حصونهم، وطلبوا من النبي(ص) أن يحقن دماءهم، ويسمح لهم بالانسحاب من الحصون، ففعل رسول الله(ص) ذلك.
وسمع أهل فدك بذلك، فنـزلوا على مثل ذلك أيضاً، فكانت لرسول الله(ص) خاصة لأنه لم يوجف عليها بخل ولا ركاب. وقد قال تعالى:- (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير)[13]، ثم نزل قوله تعالى:- (وآت ذا القربى حقه)[14]، وأوحى الله تعالى إلى نبيه(ص) أن يدفع فدكاً إلى السيدة فاطمة(ع)، فدعاها رسول الله(ص) وقال لها: يا فاطمة إن الله أمرني، أن ادفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، ولم يزل وكلاؤها فيها طيلة حياة النبي الأكرم(ص).
وبعد وفاته(ص)، وجلوس الرجل الأول، عمد إلى إخراج عمالها ووكلاءها، فجاءت إليه معترضة تطالب حقها الذي أخذ منها، لأنها نحلتها من أبيها(ص). وقد سمعت أنها قد تدرجت في الاعتراض والمطالبة، فطالبت بها على ثلاث مراحل، سبقت منا الإشارة إليها.
ولما ولي الأمر الرجل الثالث، أعطى فدك لمروان بن الحكم، وقد كان ذلك أحد أسباب ثرائه. ولم يسترجعها أمر المؤمنين(ع) عندما ولي الخلافة الظاهرية لجملة من الأسباب، ليس هذا موضع ذكرها[15].
وبعد جلوس معاوية على كرسي الخلافة، شارك مروان بن الحكم فيها، وصار مروان يعطي عمرو بن عثمان ثلثاً من ريعها، وثلثاً ليزيد بن معاوية، ويأخذ الثلث الثالث.
فلما جلس هو على الكرسي احتكر ريعها لنفسه فقط دون البقية، وأهداها بعد ذلك لولديه عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان. وأهدى عبد العزيز نصيبه لولده عمر.
ولم تسترجع فدك إلى بني الزهراء(ع) إلا في أيام عمر بن عبد العزيز، فقد دعى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وردها عليه، وقيل أنه دعى الإمام زين العابدين(ع)[16]، وبقيت فدك بيد أولاد فاطمة(ع) مدة ولايته، فلما ولي يزيد بن عاتكة، صادرها منهم من جديد، وبقيت في أيدي المروانيـين يتداولونها.
فلما صارت الخلافة لبني العباس، ردها أبو العباس السفاح على عبد الله بن الحسن بن الحسن، فلما صار الأمر إلى الدوانيقي، قبضها وصادرها منهم مرة ثانية، وردها المهدي عليهم، فلما ملك موسى الهادي صادرها، وبقيت في أيدهم إلى أيام المأمون، فلما صار الأمر إليه، كتب إليهم سجلاً بها، فردت عليهم.
فلما صار الأمر إلى المتوكل، انتزعها منهم وأقطعها عمر بن عبد العزيز البازيار، ولما هلك المتوكل، وخلفه المنتصر ابنه، أمر بإرجاعها.
وممن أرجعها أيضاً المعتضد، وأخذها المكتفي، وقيل أن المقتدر ردها عليهم من جديد، على ما جاء في كتاب كشف الغمة للشيخ الإربلي، فراجع.
وعلى أي حال، فإن أول ما طالبت به السيدة الزهراء(ع) أنها نحلة وهبها إياها رسول الله(ص) في حياته، وملكها لها، فلا يجوز لأحد أن يسترجعها منها، ويشهد لمطالبتها إياه في البداية على أنها نحلة، وأنها لم تطلبها ميراثاً إلا بعدما رفض ذلك أمران:
الأول: ما جاء في شرح نهج البلاغة، من أن أبا بكر لما قال لها إن الأنبياء لا يورثون، قالت له(ع): إنها هبة لها من رسول الله(ص)، قال: إن أبا بكر قال لها: يا ابنة رسول الله، والله ما روث أبوك ديناراً ولا درهماً، وأنه قال: إن الأنبياء لا يورثون. فقالت: إن فدكاً وهبها لي رسول الله(ص).
الثاني: ما كتبه أمير المؤمنين(ع) إلى عثمان بن حنيف، وهو: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. فإن المستفاد من العبارة المذكورة أنها كانت تحت يد السيدة الزهراء(ع) مدة حياة أبيها رسول الله(ص)، ثم انتزعت منها.
والحاصل، إن الذي تؤكده المصادر التاريخية وتساعد عليه النصوص الشرعية أن فدكاً من الفي والأنفال، والتي تكون ملكاً للنبي(ص) يتصرف فيها كيف ما يشاء، يضعها حيث يشاء، ويهبها لمن يريد، وفق سلطته وإدارته للدولة، وليس لمن جاء بعدها من المعصومين، أن يسترجع ما أعطى، ويأخذ ما وهب، فكيف بغيره.
فمن النصوص الدالة على كونها من الفيء والأنفال ما رواه علي بن أسباط، قال: لما ورد أبو الحسن موسى(ع) على المهدي رآه يرد المظالم، فقال: يا أمير المؤمنين، ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟
قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه(ص) فدك[17] وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل الله على نبيه(ص):- (وآت ذا القربى حقه)، فلم يدر رسول الله(ص) من هم، فراجع في ذلك جبرئيل(ع) وراجع جبرئيل ربه، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة(ع) فدعاها رسول الله(ص) فقال لها: يا فاطمة، إن الله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله(ص)، فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها، فأتته، فسألته أن يردها عليها، فقال: لها: ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين(ع) وأم أيمن، فشهدا لها، فكتب لها بترك التعرض، فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر، فقال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، قال: أرينيه، فأبت، فانتزعه من يدها، ونظر فيه، ثم تفل فيه، ومحاه، وخرقه، فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب، فضعي الحبال في رقابنا[18].
احتجاج الزهراء(ع):
وقد طالب الرجل السيدة الزهراء(ع) بالبينة، عندما احتجت عليه بأن رسول الله(ص) أعطاها فدكاً هبة ونحلة، ولم يقبل بمن جاءت به من الشهود، وقال لها: أبرجل وامرأة تستحقينها.
وفي ما صدر منه من تصرف وقفات:
إحداها: إن مطالبته إياها بالمجيء بالبينة لإثبات ملكيتها لها، وأنها مما نحلها إياه رسول الله(ص)، ليس في محله، حال ملاحظته الطرف الذي أمامه وهو السيدة الطاهرة الصديقة فاطمة الزهراء(ع)، وذلك لأمرين:
الأول: طهارتها(ع)، والتي وصفت بها في قوله تعالى:- (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)[19]، فإن من وصفه القرآن الكريم بهكذا صفة من المستحيل أن يأتي ليدعي شيئاً ليس له، أو يطلب حقاً لا يستحقه.
الثاني: عصمتها من الذنب والخطأ، ويستفاد ذلك من آية التطهير، ومن النصوص، مثل قوله(ص): فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل، ومن المستبعد جداً أن يتأذى رسول الله(ص) لشخص يطلب الدنيا ويرتكب الذنوب والخطايا، بل لا يتأذى إلا لمن يكون من أهل الآخرة، ومنـزهاً عن كل ذنب ومعصية، وهذا يستوجب أن لا يطلب هذا الشخص ما لا يكون حقاً له، فيثبت أنها عندما جاءت تطلب فدكاً، جاءت تطلب حقاً ثابتاً لها بمقتضى هذين الأمرين[20].
الثانية: لقد خالف الرجل في ما عمل من قضاء أحكام الإسلامية، وسنة النبي الأكرم محمد(ص)، عندما رد شهادة أمير المؤمنين(ع)، لأنه كان يمكنه أن يقوم بطلب اليمين من السيدة الزهراء(ع)، ويضم ذلك إلى شهادة أمير المؤمنين(ع)، ليكون موافقاً لما كان يفعله النبي(ص)، فإن الوارد عن ابن عباس وعن أبي الدرداء، أن رسول الله(ص)، قضى بشاهد ويمين[21].
الثالثة: إن الثابت فقهياً أن اليد أمارة الملكية، وقد كانت يد السيدة الزهراء(ع) على فدك، فلا حاجة إلى مطالبتها بشاهدين يثبتان ملكيتها لها، بل كان على الرجل هو أن يأتي بما يثبت خلاف ذلك. ولهذا احتج عليه أمير المؤمنين(ع)، بأنه يقضي فيهم بخلاف ما يقضى في المسلمين، فقد روي أنه(ع) لما تقدم إلى أبي بكر للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة(ع)، قال: يا أبا بكر، انشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه، قال: قل، قال: أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شيء هو في يد أحدهما دون الآخر، أكنت تخرجه من يده، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ قال: لا، قال: فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ قال: أطلب البينة من المدعي، وأوجب اليمين على من أنكر، فإن رسول الله(ص) قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال له علي(ع): أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ قال: وكيف ذلك؟ قال: إن الذين يزعمون أن رسول الله(ص) قال: ما تركناه فهو صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب، وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول الله(ص) في يد ورثته إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه، وعلى ورثة رسول الله(ص) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك، فمتى فعلت غير ذلك فقد خالفت نبينا(ص)، وتركت حكم الله وحكم رسوله، إذ قبلت شهادة أهل الصدقة علينا، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا، فهل هذا إلا الظلم والتحامل[22]!؟
شبهة وجواب:
وقد يدافع عن الرجل، فيقال: بأن ما قام به على طبق القاعدة التي يلتـزم بها جملة من فقهاء الإمامية، من انقلاب المنكر إلى مدعٍ، فيطالب البينة، توضيح ذلك:
لقد نص الأعلام في بحث قاعدة اليد على أنه لو أقرّ ذو اليد بثبوت ملكية ما تحت يده إلى شخص آخر قبله حال منازعته ملكيتها من قبل آخرين، كما لو أقرّ بأن السيارة التي عنده كانت ملكاً من قبلُ لأبيه، وقد انتقلت إليه بالهبة مثلاً، فقد التـزم هؤلاء الأعلام بأن إقراره هذا يوجب انقلاب الأمر ليصبح صاحب اليد على السيارة مدعياً بعدما كان منكراً، ويطالب البينة لإثبات أنها له هبة من أبيه.
وهذا هو الذي جرى في المقام، ذلك أن الصديقة الطاهرة فاطمة(روحي فداها)، قد أقرت أن فدكاً كانت تحت يد سيدي رسول الله(ص)، ثم نحلها إياها، فانقلبت من كونها منكرة إلى كونها مدعية تطالب البينة، لأن هناك من ينكر ملكيتها لها بنحو النحلة والهبة.
وقد ذكر بعضهم أن الحاجة لمعالجة هذا الإشكال، تعود للبناء على اعتبار الرواية التي تضمنت احتجاج أمير المؤمنين(ع)، على الرجل، وأن المقام من صغريات قاعدة اليد، فلو أنكرنا جريان القاعدة في المقام، لأحد سببين:
الأول: من المعلوم وفقاً لما تضمنته المصادر التاريخية أن قرية فدك منطقة مترامية الأطراف، ومجرد وجود عامل عليها يقوم بزراعتها، لا يثبت قيام اليد على الأرض، فلا تكون صغرى للقاعدة.
الثاني: لقد نصت المصادر التاريخية أن قرية فدك تبعد عن المدينة المنورة مسيرة يومين، وقيل ثلاثة أيام، وما كان هكذا حاله، فإن إثبات اليد عليه يحتاج إلى مؤونة زائدة، ما يمنع من تحقق موضوع القاعدة.
أو بنينا على ضعيف سند الرواية المستند إليها، لأنها مروية بطرق ثلاثة:
الأول: وقوعها في بعض الكتب، ككتاب سليم بن قيس الهلالي، وأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي، المسمى بالاستغاثة، من دون سند، كما هو المذكور في مستدرك الوسائل[23].
الثاني: ما رواه الشيخ الصدوق(ره) في العلل، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله(ع). وهو مرسل، لعدم ذكر الواسطة بين ابن أبي عمير، وبين الإمام الصادق(ع)، فلا يدخل الخبر دائرة الحجية بسبب الإرسال.
ومجرد كون المرسل ابن أبي عمير، لا ينفع شيئاً، لأن كبرى المشائخ الثقات، لا تصلح للاعتماد عليها في المراسيل، وإنما تنفع في المسانيد، لأن من المقطوع به روايتهم عن الأشخاص غير الموثقين، ومع الشك في المرسل عنه أنه واحد منهم أو لا، يكون التمسك بالكبرى المذكورة تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية، المقرر في محله منعه.
الثالث: ما ذكره صاحب الوسائل، عن تفسير علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه…ألخ….والطريق المذكور وإن كان صحيحاً، إلا أن المشكلة تكمن في مصدره، فإن النسخة التي وصلت لصاحب الوسائل، لا يحرز أنها كتاب علي بن إبراهيم القمي.
لن يبقى للإشكال المذكور مجال، وبالتالي لا حاجة لما تضمنته كتب الأعلام من معالجات[24].
وما ذكره من البناء على عدم كون فدك صغرى لقاعدة اليد، لو سلم به، إلا أن العلاج من خلال المناقشة السندية غير تام، لأنه مناقشة صغروية تعتمد على المبنى، فلو بني على القبول بمراسيل ابن أبي عمير، كما هو المشهور، كان ذلك موجباً لتمامية الطريق الثاني، كما أنه لو بني على صحة النسخة الموجودة بأيدينا لكتاب علي بن إبراهيم القمي، كما هو مختار بعض الأعاظم(ره)، ومن قبله صاحب الوسائل(ره)، كان الأمر كذلك.
على أن المناقشة في انطباق المقام لصغرى قاعدة اليد، للوجهين المذكورين، كما ترى، فإن الارتكاز العقلائي قائم على ثبوت ملكية الشخص للشيء بوضع اليد من خلال وجود الوكلاء والعمال، لأن المقصود بوضع في كل شيء بحسبه، ومثل ذلك يجري في المناطق المترامية الأطراف والواسعة، وتفصيل ذلك أكثر يطلب مما يذكر في قاعدة اليد.
وكيف ما كان، فقد تضمنت كلمات الأعلام أجوبة متعددة، نذكر منها ما ذكره المحقق النائيني(ره)، وقد تضمن جوابه(ره) التفصيل في المقام، لأنه ذكر صوراً ثلاثة للمسألة:
الأولى: أن يكون الإقرار الصادر من ذي اليد صادراً للمدعي، وهنا يتحقق الانقلاب، فيلزم صاحب اليد البينة.
الثانية: أن لا يكون الإقرار للمدعي نفسه، بل هو إقرار للمورث، كما في المثال السابق، فإن من تحت يده السيارة يقر بأنها لأبيه، فهنا أيضاً يتحقق الانقلاب، لأن اقراره للمورث، بالنتيجة إقرار للوارث، ويكون مطالباً بالبينة أيضاً.
الثالثة: أن لا يكون الإقرار للمدعي نفسه، بل هو إقرار للموصي، كإقرار السيدة الزهراء(ع) للنبي الأكرم(ص)، بناء على أنه(ص) قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وهنا لا يحصل الانقلاب، فلا يطلب من صاحب اليد البينة. لأن الإقرار وإن كان للموصي، إلا أنه لا يعتبر إقراراً للموصى له، لأنه تثبت الملكية للموصي، لكن لا يلزم أن يكون جميع ما كان ملكاً للموصي قد أوصى به للموصى إليه.
ومن المعلوم أن نسبة المسلمين للنبي الأكرم(ص) في فدك نسبة الموصى له، سواء كان ذلك من باب الوصية التمليكية، أو كان من باب الوصية العهدية-كما هو الأظهر-فحينئذٍ لا يوجب إقرار السيدة الزهراء(ع) بملكية النبي(ص) لها انقلاب الدعى لتكون مدعياً بعدما كانت منكراً، فتطالب البينة.
وبالتالي لا يصح طلب الرجل من السيدة الزهراء(ع) البينة، ويكون الاحتجاج الصادر من أمير المؤمنين(ع) في محله[25].
وقد أوجب تفصيله بين الوراث والموصي اعتراضاً من الأعلام عليه، لقولهم بعدم وجود فرق بينهما، وبالتالي إما أن يلتـزم بالانقلاب فيهما معاً، أو يلتـزم بعدم الانقلاب فيهما.
وقد عمد بعض الأساتذة(وفقه الله) لترميم ما ذكره المحقق النائيني(قده)، وحاصل ما أفاد:
إن الارتكاز العقلائي قائم على تحقق الانقلاب مطلقاً إذا كان الإقرار بثبوت الملكية للمدعي، سواء كان وارثاً، أم كان موصى له، شرط أن يكون منكراً لحصول الانتقال، فلو كان المسلمون وهم الذين يمثلون طرف الدعوى ضد الصديقة الطاهرة فاطمة(ع) منكرين لحصول انتقال فدك إليها من النبي(ص)، بني على تحقق الانقلاب، وتحولت الصديقة الزهراء(ع) من كونها منكرة إلى كونها مدعية، ويكون مطالبتها البينة في محله.
أما لو كان الإقرار بالملكية لغير المدعي، كما لو كان الإقرار بذلك للمورث، أو للموصي، فعندها إن كان طرف الدعوى جاهلاً بالحال، وليس منكراً لحصول الانتقال، فإنه لا يتحقق الانقلاب حينئذٍ، وعند المراجعة للمصادر التاريخية لا نجدها تتضمن إنكاراً من المسلمين لحصول الانتقال للسيدة الزهراء(ع)، ولا تكذيباً منهم لها في ذلك، وهذا يعني أنهم لو لم يكونوا مصدقين إليها في النحلة الهبة، لا أقل من أنهم لا ينكرون ذلك عليها، وهذا مانع من تحقق الانقلاب[26].
وعليه، يكون الاحتجاج الصادر من أمير المؤمنين(ع)، على الرجل في مطالبته السيدة الزهراء(ع) بالبينة، قضاء على خلاف ما يقضي به في المسلمين، ومخالفة لما جرت عليه سيرة النبي الأكرم محمد(ص).
[1] أمالي الصدوق ح 2 ص 129-130.
[2] بناء على أن الفي في الآية رقم من سورة الحشر يغاير الفي في الآية رقم من نفس السورة، سوف يكون ذكر الغنيمة في القرآن الكريم مرتين، أما بناء على أنه هو نفسه، فسوف يكون ذكر الفيء في القرآن الكريم مرتين، وسيتضح الحال في ذلك ضمن طيات البحث إن شاء الله تعالى.
[3] سورة الأنفال الآية رقم 1.
[4] سورة الأنفال الآية رقم 41.
[5] سورة الحشر الآية رقم 6.
[6] الصحاح ج 1 ص 63.
[7] مفردات غريب القرآن ص 389.
[8] تضمنت بعض المصادر التاريخية، أن فدك كانت ملكاً خاصاً للنبي(ص)، لكنها لم تذكر منشأ ملكيته الخاصة، ولعل ذلك لما سيأتي من أن المعصوم(ع) يمكنه أن يتملك ما يشاء من الأموال العامة للمنصب.
[9] وسائل الشيعة ج 9 ب 1 من أبواب الأنفال ح 1 ص 523.
[10] تفسير سورة الحشر، للسيد الحكيم، ص 84-85 (بتصرف).
[11] سورة الحشر الآية رقم 7.
[12] وسائل الشيعة ج 9 ب 1 من أبواب الأنفال ح 12 ص 527.
[13] سورة الحشر الآية رقم 6.
[14] سورة الإسراء الآية رقم 17.
[15] يكفي أن يلتفت القارئ العزيز أنه(ع) لم يشأ أن يستغل منصبه الظاهري لإرجاع حق مسلوب، ولو قام بذلك لم يثبت أنها كانت مسلوبة، بل ربما فهم عامة المسلمين، ن هذا من أنحاء الإقطاع الذي كان يقوم به من سبقه، لأنه كان لازماً عليه إثبات خطأ السابقين عليه، حتى يقنع الحاضرون أن ما فعله حق، وليس مجاراة ومماثلة لهم، وعند قراءة الأحداث التي واجهته(ع) في مقام الإصلاح يتضح أنه لم يكن من السهل قيامه بذلك.
[16] نقل الشهيد السعيد السيد الصدر(ره) في كتابه فدك في التاريخ حديثاً ع عمر بن عبد العزيز، يفيد أنه لم يرجعها لآل الزهراء(ع) اعتقاداً منه أنها نحلة لرسول الله(ص)، وإنما هو شيء مملوك له من أبيه، ومن الشراء أو الهبة من أخوته، فردها، وقد طلب منه أن يعطيهم الأصل، ويقسم الغلة ففعل.
[17] في المصدر جاءت هكذا، على أساس أنها ممنوع من الصرف.
[18] الكافي ج 2 كتاب الحجة باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ح 5 ص 725.
[19] سورة الأحزاب الآية رقم
[20] الصديق الأكبر ص 615-616.
[21] سنن أبي داود ج 3 ص 419 باب القضاء باليمين والشاهد.
[22] مستدرك وسائل الشيعة ج 17 ب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ص 397.
[23] مستدرك الوسائل ج 17 ح 1، ح2 ص 397-398.
[24] قاعدة اليد ص 67-68.
[25] فوائد الأصول ج 4 ص 615-616(بتصرف)
[26] قاعدة اليد ص 70.