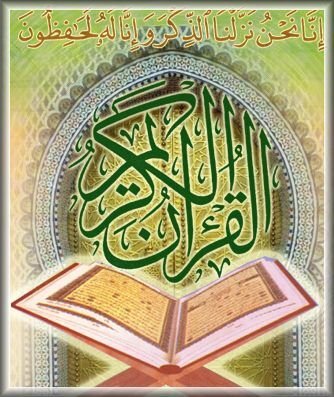الظهورات القرآنية بين الثبات والتغير
تضمن القرآن الكريم العديد من المفاهيم وفي موضوعات مختلفة، فقد وردت فيه مفاهيم عقدية، كالتوحيد، والعدل، والنبوة والإمامة، والمعاد، كما جاء فيه مفهوما الجنة والنار. وتضمن أيضاً مفاهيم عبادية، كالصلاة والصوم، والزكاة، والخمس، والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أنه قد احتوى مفاهيم اجتماعية قيمية أخلاقية، كبر الوالدين، وصلة الرحم، وكذلك مفاهيم تربوية، كآداب الحوار، وآداب الطريق، وغير ذلك.
ومن المعلوم أن لكل مفهوم قد ذكر في القرآن الكريم مصداق خارجي واضح يشير إليه، ويعرف به، فمفهوم النبوة مثلاً مصداقه الخارجي واضح في الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله تعالى لهداية البشر وإخراجهم من الضلال إلى الهدى، ومفهوم الصلاة حقيقته واضحة في تلك العبادة المشروطة بشروط كالطهارة وخروج الوقت والاستقبال، والتي تكون بكيفية معينة، وهكذا بقية المفاهيم الأخرى.
ومع تضمن القرآن الكريم لمفاهيم متعددة، لها مصاديق خارجية، يتبادر إلى الأذهان سؤال حولها، وأنها مفاهيم ثابتة لا تتغير عما كانت عليه في عصر نزول القرآن الكريم، أم أنها قابلة للتغير والتبدل، وفق مقتضيات الحياة في كل زمان ومكان، فيمكن أن تكون المفاهيم التي تضمنها القرآن الكريم ذات حقيقة مختلفة عما كانت عليه في عصر نزوله في يومنا هذا، بسبب الظروف المكانية والزمانية التي نعيش فيها. بحيث يمكن الالتـزام بتغير مفهوم الحج مثلاً الذي كان موجوداً في عصر نزول القرآن الكريم، ليكون بمعنى آخر غير المعنى الذي كان معروفاً في وقت تشريعه، لأن الزمان قد تغير. وكذا أيضاً يمكن البناء على تغير مفهوم صلة الرحم، وهكذا بقية المفاهيم الأخرى.
ولا ينحصر الأمر في خصوص المفاهيم، بل يجري ذلك في المصاديق بطريق أولى، ذلك أنه متى ألتـزم بقبول المفاهيم للتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان، فلابد وأن يلتـزم بثبوت ذلك في المصاديق أيضاً، كما يمكن أن يلتـزم بثبوت التغير فيها، مع البناء على ثبوت حقيقة المفاهيم وعدم تغيرها. فيلتـزم بتغير الصلاة الخارجية مثلاً فيكون المصداق الخارجي للصلاة الموجودة في القرآن الكريم يختلف اليوم عما كانت عليه الصلاة الموجودة في عصر تشريعها، ونزول القرآن الكريم بها.
وكذا يمكن البناء على تغير مصداق بر الوالدين، فبعدما كان يتحقق برهما بالأمس في وقت نزول القرآن الكريم من خلال الذهاب إليهما والجلوس معهما، فإنه يمكن تحققه اليوم من خلال رسالة نصية ترسل إليهما، أو من خلال مكالمة هاتفية، وكذا يمكن البناء على تغير مصداق صلة الرحم، بحيث تتبدل صورتها الخارجية أيضاً عما كانت عليه سابقاً، وهكذا.
ومن الواضح، أن الجزم بأحد الاحتمالين المذكورين، من البناء على الثبات وعدم التغير، بحيث يكون الظهور الحاصل عندنا اليوم موافقاً لما كان عليه في عصر نزول القرآن الكريم، أو البناء على التغير، في المفاهيم، يستدعي الحديث عن أمور، كحجية الظهورات، وتحديد الظهور الذي يكون حجة، وهكذا. وكذا الحال بالنسبة للمصاديق.
حجية الظهورات:
ويقصد بالظهورات، عبارة عن دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب العزيز، أو السنة المباركة[1] على معانيها، ومن المعلوم أن دلالة أي لفظ على معناه لا تخرج عن محتملات ثلاثة:
الأول: أن تكون دلالته عليه بالنص، بحيث يكون للفظ معنى واحداً فلا يحتمل معنى آخر غيره، مثل قوله تعالى:- (فاجلدوهم ثمانين جلدة)[2]، فإن العدد متعين في أمر محدد، وهو الثمانون فلا يحتمل مدلولاً آخر كالسبعين أو التسعين.
الثاني: أن تكون دلالة اللفظ على المعنى متعددة، بحيث يحتمل اللفظ أكثر من معنى، وجميعها متكافئة في نسبتها إلى اللفظ فكما يكشف اللفظ عن المعنى الأول، فهو بنفس المقدار يكشف عن المعنى الثاني، وبنفس المقدار يكشف عن المعنى الثالث، وهكذا، وهذا مثل لفظة اليد الواردة في قوله تعالى:- (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)[3]، فإن لفظ اليد يحتمل أن يكون المقصود به الكف، ويحتمل أن يكون المقصود به ما يغسل في الوضوء، ويحتمل أن يكون المقصود به شيء آخر. وكذا لفظة العين، فإنها تطلق على العين النابعة، وعين الركبة، وعين الذهب، وكذا لفظة الهلوع في قوله تعالى::- (إن الإنسان خلق هلوعاً)[4]، ولفظة السندس والإستبرق في قوله تعالى:- (عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق)[5]، وهكذا.
الثالث: أن يحتمل اللفظ معنيـين أو أكثر، إلا أن ارتباطه بأحدها أقوى وأوضح من ارتباطه بالبقية، مثل صيغة الأمر فإن لها معنيـين الوجوب والاستحباب، إلا أن ظهورها عرفاً في الوجوب أوضح وأقوى من ظهورها في الاستحباب، وهذا يجعل التبادر والانصراف الذهني إليه بمجرد ذكرها.
ولا يخرج الدليل الشرعي عن هذه المحتملات الثلاثة في دلالته على الحكم الشرعي، أو غيرها، وهذا يعني أن جميع الألفاظ الوارد ذكرها في الآيات القرآنية لا تخرج دلالتها على معانيها عن واحد من هذه المحتملات المذكورة، فإما أن تكون دلالتها عليها بالنص، أو تكون مجملة، أو يكون لها ظهور في أحد المعاني أقوى من ظهورها في البقية.
وينصب البحث في الحديث عن الحجية وعدمه في المحتمل الثالث، إذ لا حاجة للحديث عن حجية المحتمل الأول، وفي المحتمل الثاني كلام، ذكره الأعلام في البحوث الأصولية.
والحاصل، مورد البحث عادة هو المحتمل الثالث، وأن ظهور اللفظ في أحد المعاني بسبب أقوائيته مثلاً، حجة يعول عليه في مقام المحاورة ويرتب عليه الأثر أو لا. بحيث يكون المكلف ملزماً بالأخذ به، فيستحق اللوم والعقوبة والعتاب من الشارع المقدس حال تخلفه عنه، ويكون مورداً للثواب متى عمل على وفقه. ويستحق المدح من العقلاء.
والصحيح هو البناء على حجيته، ولزوم الأخذ به، لأن ذلك موافق لما عليه طريقة العقلاء، إذ أن الطريقة المعتمدة عندهم في مقام المحاورة وتبادل المعلومات والمفاهمات قائمة على مثل هذا الأمر، وانتهاج هذا الأسلوب. ولو أنهم لم يعتمدوا هذا الأسلوب لكان ذلك موجباً لحصول الاختلال في النظام الحياتي، ولصعب إيجاد سبل وسائل للتفاهم بينهم.
ولم تختلف طريقة الشارع المقدس عن العقلاء، لأنه منهم، بل هو رئيسهم، وسيدهم، فسار على نفس ما هم عليه من الاعتماد على الظهورات في مقام المحاورات والمفاهمات، وتبادل المعلومات.
ولو كانت له طريقة أخرى غير ما هم عليه، لأفصح عنها وبينها، وأشار إليها، حتى يستعملها المكلفون في مقام الامتثال.
أدلة حجية ظواهر الألفاظ:
ويدل على حجية ظواهر الألفاظ أمور:
أحدها: سيرة المتشرعة:
ويختص ذلك بما كان منها معاصراً للمعصوم(ع)، فإنها قائمة على العمل بظهور الكلام، وهي مأخوذة من المعصوم(ع) مباشرة، فيكون العمل على وفقها حجة. ويساعد على قبولها أنها لو لم تكن كذلك بحيث كان للمتشرعة طريقة أخرى مغايرة، لأفصحوا عنها وبينوها، وأشاروا إليها.
والحاصل، إن سيرة المتشرعة قائمة على استكشاف مراد المتكلم على العمل بظواهر الألفاظ والاستناد إليها.
ثانيها: سيرة العقلاء:
فإنها منعقدة على معرفة مراد المتكلم في كافة شؤون معاشه وأوضاعه الحياتية من خلال الاعتماد على ظواهر الألفاظ المستفاد من كلامهم خلال المحاورة، ولو لم تكن هذه السيرة مرضية عند الشارع المقدس، لعمد للردع عنها، ومنع من العمل على طبقها، فسكوته كاشف عن امضائه إياها وقبوله بها.
ثالثها: جملة من النصوص:
وهي طائفتان:
الأولى: النصوص التي تضمنت الأمر بالتمسك بالكتاب العزيز، والسنة الشريفة، مثل حديث الثقلين، وهو قوله(ص): إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. ونحن نعلم أنه لا يكون التمسك بالكتاب إلا من خلال العمل بما جاء فيه، وقد تضمن الكتاب نصاً وظاهراً ومجملاً، ولا يمكن أن يكون المقصود من التمسك به حصر العمل به في خصوص ما كان من دلالة اللفظ على المعنى بنحو النص، لأن ذلك ليس كثيراً، فيكون المقصود منه العمل بظواهر الألفاظ المستفادة منه، كالعمل بما كان منها نصاً.
الثانية: النصوص التي تضمنت استناد المعصومين(ع) إلى ظواهر الألفاظ المستفادة من الآيات القرآنية، وهي كثيرة:
منها: صحيحة زرارة الواردة في الوضوء، قال: قلت لأبي جعفر(ع): ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله(ص) ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال:- (فاغسلوا جوهكم)، ثم فصل بين الكلام فقال:- (وامسحوا بروءسكم)فعرفنا حين قال: برؤوسكم، أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس[6]. فإنه(ع) قد تمسك بظهور لفظة الباء في التبعيض، وهذا يكشف عن حجية ظواهر الكتاب.
إن قلت: إن من المحتمل جداً أن يكون الاستناد إلى ظواهر القرآن الكريم أمر خاص بهم(ع)، لأنهم أعرف به، فإنه نزل القرآن الكريم في بيوتهم، وهم المخاطبون بذلك[7].
قلت: إن الاختصاص المذكور مدفوع، بقاعدة التأسي التي أمرنا بالعمل على طبقها، لقوله تعالى:- (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)[8]، ولم يرد ما يشير لتخصيص التأسي بهم(ع) في شيء دون آخر[9].
كيفية تحصيل الظهور:
ويمكن للإنسان تحصيل ظهورات الألفاظ من خلال طريقين:
الأول: الرجوع للمصادر اللغوية:
فإن كل لغة وضعت الألفاظ للدلالة على المعاني، فكل لفظ وضع للدلالة على معنى خاص له دون غيره.
الثاني: العرف:
فإن هناك مفاهيم تتبادر إلى الأذهان معاني من ألفاظها بمجرد إطلاقها وسماعها، فيفهم عموم الناس ذلك المعنى ولو كانوا جاهلين بالوضع، مثل مفهوم: الصلاة، الحج، الخمس، وما شابه ذلك.
ومقتضى ما تقدم، البناء على حجية الظهورات سواء كانت قرآنية، أم كانت من السنة الشريفة. نعم قد منع مشايخنا الإخباريون رضوان الله تعالى عليهم من حجية الظهورات القرآنية، اعتماداً على وجوه، منها: النصوص التي تضمنت أنه لا يفهم القرآن الكريم إلا خصوص من خوطب به[10].
موضوع الحجية هو عصر الصدور، وليس زمان الوصول:
ثم إنه بعد الفراغ عن حجية الظهورات، سواء منها الظهورات القرآنية، أم السنة الشريفة، يلزم تحديد المقصود منها، وأنها ما كان في زمان نزول القرآن الكريم، أم أن موضوعها هو زمان من وصل إليهم القرآن، وما تضمنه من مفاهيم.
ويعود طرح هذا البحث إلى أن اللغة موجود حي له تطور وتكامل وانتكاس، وله تغير وتبدل، فحالها حال أي موجود حي آخر، وحكمها حكمه، فكما أن الموجودات الحية تتطور وتتكامل، وتؤثر فيها الشرائط المختلفة، كذلك اللغة، ويشهد لذلك أن اللفظة الواحدة يمكن أن تشير في هذا الزمان إلى معنى يختلف تماماً عن معناها في الزمن السابق، وجملة يسمعها اليوم، ويسكت عليها لتبادر معنى إلى ذهنه منها، يختلف عن المعنى الذي كان يتبادر منها قبل خمسمائة سنة مثلاً، فعندما يسمع اليوم قوله تعالى:- (فلا أقسم برب المشارق والمغارب)[11]، يتبادر إلى ذهنه حركة الأرض ودورانها بخلاف من يعتقد أنها ساكنة، فلو بني على أن الحجة هو ظهور اللفظ في عصر نزول القرآن، كان ذلك مانعاً من الاستفادة منه اليوم، لأنه لن يمكن الإنسان المعاصر اليوم الوصول للمعنى المستعمل في ذلك الزمان لهذه الألفاظ بسبب اختلاف الزمان والظروف والشرائط، وهذا يجعل الحجة لخصوص الظهور الذي يفهمه الإنسان الموجود في كل عصر عصر، وهو زمان الوصول.
ثم إنه لما كان الظهور الحاصل للإنسان في كل عصر يختلف عن الظهور وقت نزول القرآن الكريم، فهل يحكم بحجيته، ويترتب عليه أثر أم لا؟ مثلاً قوله تعالى:- (وجاءت سيارة)[12]، فإن للفظة سيارة في الآية الشريفة مدلولاً معيناً في زمان نزول القرآن الكريم، لكنه وبسبب التطورات التي حصلت في الحياة البشرية، صارت تحمل معنى آخر يختلف عما كانت عليه في ذلك الزمان، فهل يحمل اللفظ الوارد في الآية الشريفة على خصوص المعنى المتبادر إلى الأذهان اليوم، أم أنه يبنى على بقائه على ما كان عليه في وقت نزول القرآن الكريم.
ويجري الأمر أيضاً بالنسبة إلى رأس المال، المذكور في قوله تعالى:- (فلكم رؤوس أموالكم)[13]، وهكذا مفاهيم متعددة.
ولا يخفى أن جريان هذا البحث حال البناء على وجود ظهور اليوم يغاير الظهور الذي كان موجوداً في عصر نزول القرآن الكريم، وصدور النصوص الشريفة عن المعصومين، وإحراز ذلك.
أما لو بني على عدم وجود المغايرة بين الزمانين، بمعنى أن الظهور الحاصل اليوم لهذه المفاهيم التي تضمنها القرآن الكريم، لا تختلف عما كانت عليه وقت نزوله، فلن يكون للبحث المذكور مجال أصلاً.
والذي يقرره الأعلام، أنه لم يثبت أن الظهور المستفاد من الألفاظ اليوم يغاير الظهور الذي كان في زمان نزول القرآن الكريم، بل هما واحد لا فرق بينهما، ويستدلون لذلك بدليل له مسميات متعددة، منها تسميته بأصالة عدم النقل، وقد يعبر عنه باستصحاب القهقرائي[14]، أو بأصالة الثبات في اللغة، وغير ذلك من التعبيرات التي تصب في مؤدى واحد.
وحاصل المقصود من أصالة الثبات في اللغة هو: بناء العرف على استقرار اللغة وثباتها، فيكون الظهور الذي قد أحرز في زمان الوصول موافقاً للظهور الحاصل في وقت نزول القرآن الكريم، وليس شيئاً آخر.
منشأ ذلك يعود إلى تطور اللغة بصورة بطيئة، فيكون ثباتها نسبياً.
ويدل على أصالة الثبات عدم النقل، أمران:
الأول: السيرة العقلائية:
فإن سيرتهم منعقدة وقائمة على ترتيب الآثار على الأوقاف والوصايا الموجودة في الوثائق القديمة طبق ما يفهمه المتولي في عصره حتى لو كان ذلك بعيداً عن عصر الوقف.
وكذا الوصية، فإن الموجود في الخارج أنه لو وصلت لشخص وصية عمرها الزمني أكثر من مائتين سنة، فإنه يقوم بترتيب الآثار بالعمل على وفق ما يفهمه وما يستظهره في زمان قراءته للوصية، وهذا يعني وحدة الظهور الموجود في زمانه، مع الظهور الذي كان في زمان كتابة الوصية، مع وجود هذا الفارق الزمني.
الثاني: سيرة المتشرعة:
فإن المراجع لسيرتهم، يجدهم أنهم كانوا في عصر الإمام العسكري(ع) مثلاً ومع بعدهم عن زمان نزول القرآن الكريم، ما يقارب من القرنين والنصف، يعملون على وفق ظواهره، وهذا يعني اعتمادهم على أصالة عدم النقل، لأن عملهم كان قائماً على وفق الظهور الموافق لزمانهم، وعدم الإشارة إلى كونه مخالفاً للظهور الذي كان في عصر نزول القرآن الكريم، بل كان عملهم على أساس عدم الاختلاف بين الظهورين، واتحادهما معاً. ولم نجد من الإمام العسكري(ع) ردعاً عن ذلك، مع أنه كان متمكناً من الردع لو أراد[15].
المفاهيم والمصاديق القرآنية بين الثبات والتغير:
بعد البناء على حجية الظهور النوعي الموضوعي، وأنه لن يختلف الظهور عند المستظهر وقت وصول القرآن إليه، عما كان عليه الظهور في عصر نزوله، ولن يكون مخالفاً له، فهل يعني ذلك ثبات المفاهيم القرآنية وبقاءها على حالها دون تغيـير أو تبدل، أم أنها قابلة للتغيير حسب تغير الزمان والمكان؟
ويجري الكلام في المصاديق القرآنية كما يجري في مفاهيمه، فيقال: هل أن المصاديق القرآنية تقبل التغيـير والتبدل وفق معطيات الزمان والمكان، فتتغير حسب تغير الزمان والمكان أو لا؟
ألتـزم بعض الأساتذة(وفقه الله)، بعدم الثبات في المفاهيم القرآنية، وفي مصاديقها من دون فرق بين مفهوم ومفهوم، ومصداق ومصداق، فجميعها قابلة للتغير والتبدل، بسبب دخالة الزمان والمكان في ذلك[16].
وتحقيق الحق في المقام، يستدعي الإحاطة بحال المفاهيم القرآنية، ومدى قابليتها للتغير من عدمه، وهي لا تخرج عن احتمالات ثلاثة:
الأول: البناء على ثبوت الوضع اللغوي والظهور فيها وعدم التغير، سواء تغير الزمان والمكان أم لم يتغيرا، وهذا مثل كافة المفاهيم العبادية، كمفهوم الحج مثلاً، فإنه لن يخرج عن كون المقصود منه قصد بيت الله الحرام في وقت معين، بشروط معينة، لعمل معين، وهذا يجري في كل زمان ومكان، حذراً من تبدل الشريعة السمحاء، وما تضمنته من تعاليم، وعليه، يكون مفهوم الحج في قوله تعالى:- (وأذن في الناس بالحج)[17]، ثابت غير متغير لثبات الوضع اللغوي والظهور.
الثاني: أن يحصل عند الإنسان علم بحصول التبدل والتغير للمفهوم عما كان عليه، بحيث يكون المستفاد منه في وقت وصوله مغايراً لما كان المستفاد منه في وقت نزول القرآن، مثل قوله تعالى:- (وجاءت سيارة)[18]، وهنا يكون الحكم على الظهور في وقت الوصول، وليس على الظهور في وقت النـزول والصدور.
الثالث: أن يحصل الشك في حصول التغير ما بين زمان النزول والصدور، وبين زمان الوصول، والمناط في هذه الحالة على زمان الصدور، وليس على زمان الوصول.
ومن خلال ما تقدم، يتضح عدم تمامية القول بقابلية المفاهيم القرآنية للتغير مطلقاً، نعم تغيرها في الجملة كما سمعت مما لا إشكال، لقيام الدليل على ذلك، إلا فالدليل على عدم التغير.
وأما المصاديق، فإن منشأ التغير فيها لن يخرج عن محتملات ثلاثة:
أولها: أن يكون ذلك راجعاً إلى فقد المصداق لبعض الشروط المعتبرة فيه، بحيث يكون المصداق الجديد الحاصل خارجاً مغايراً له.
وهذا التغير موضع قبول ورضا عند الأعلام، ومحل التـزام منهم، نعم قد يحتاطون في مقام الفتوى لبعض الموجبات والأسباب وليس هذا محل ذكرها.
ثانيها: أن يكون المقصود من التغير وجود مصاديق جديدة مغايرة للمصاديق التي كانت في عصر صدور النص ونزول القرآن الكريم، كبعض العقود التي لم تكن موجودة في تلك الحقبة الزمنية، كعقد التأمين مثلاً.
وليس هذا موضع خلاف بين الأعلام أيضاً، ذلك أنهم ملتـزمون بجريان التغير فيه، واندماجه تحت مفهوم العقود المذكور في القرآن الكريم، لعدم تحديد مصداقه بما كان في عصر النزول، بل يشمل كل ما كان ينطبق عليه عنوان العقد.
ثالثها: أن يكون منشأ التغير راجعاً لعدم مناسبة المصداق للواقع الحياتي اليوم نتيجة التطور وتبدل الأوضاع والحقائق.
وهذا أيضاً موضع قبول ورضا عند الأعلام، وقد ذكروا له مصاديق متعددة، مثل قوله تعالى:- (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل)[19]، فإن الآية الشريفة تدعو للدفاع عن بيضة الإسلام، ومن الواضح جداً أن طريقة الدفاع عنه اليوم تختلف تماماً عما كانت عليه في وقت نزول القرآن الكريم، إذ لا ريب أنه لن يحتاج للدفاع عنه للخيل والرماح والسيوف والسهام، بل قد تكون وسيلة ذلك اليوم القلم، واللسان، وجودة البيان.
ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى:- (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[20]، فإن مصداق جعل السبيل للكافرين اليوم يختلف عما كان عليه في عصر نزول الآية المباركة أيام حياة النبي الأكرم محمد(ص).
ومن خلال ما تقدم، يتضح عدم تمامية ما جاء في كلام بعض الأساتذة(زيد في توفيقه) وأصر عليه من أن الموجود في الحوزة هو ثبات المصاديق وعدم تغيرها، وأنه قد جاء بنظرية جديدة، جديداً، بل إن البناء على تغير المصاديق ولو في الجملة مما كان معروفاً وملتـزماً به عندهم.
[1] بل مطلق المحاورات القائمة بين الناس في الخارج، فيشملها ظهور اللفظ، وإنما خصصنا الدليل الشرعي بالذكر، لأنه محور البحث.
[2] سورة النور الآية رقم 4.
[3] سورة المائدة الآية رقم 38.
[4] سورة المعارج الآية رقم 19.
[5] سورة الإنسان الآية رقم 21.
[6] وسائل الشيعة ج ب
[7] مضمون هذا الكلام تمسك به مشايخنا الإخباريون، وبنوا عليه المنع من حجية ظواهر الكتاب، ولو في الجملة.
[8] سورة الأحزاب الآية رقم 21.
[9] مباحث الدليل اللفظي ج 4، تبيـين الأصول ج 3 ص 79(بتصرف).
[10] تعرضنا للحديث عن حجية ظواهر الكتاب الكريم، ومناقشة مشايخنا الإخباريين(رضي الله تعالى عليهم)
[11] سورة المعارج الآية رقم 40.
[12] سورة يوسف الآية رقم 19.
[13] سورة البقرة الآية رقم 279.
[14] أكثر الأعلام قد ناقشوا في الاستناد إليه، بسبب عدم توفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب التي يلزم توفرها في جريانه.
[15] بحوث في علم الأصول للسيد الشهيد الصدر(ره) ج 9 ص 382(بتصرف).
[16] لكنه بعد أيام قلائل، وفي محاضرة بتاريخ 2 ربيع الثاني من سنة 1438 هــ، قال بأنه لم يقل ذلك، وإنما هو ملتـزم بوحدة المفاهيم القرآنية وعدم تغيرها، والذي يتغير هو خصوص المصاديق.
والظاهر أن كلامه الأول كان من باب سبق اللسان، مع أن كلامه يوحي بالإصرار عليه، والعصمة لأهلها.
ثم إنه بعد التسليم بأن الأستاذ(وفقه الله)، ليس ملتـزما بالتغير في المفاهيم، لبناءه على نظرية سماها وحدة المفهوم وتعدد المصاديق، يظهر أنه لم يأت بجديد يخالف أعلام وأعيان الطائفة.
وبناء على ما صدر منه(وفقه الله) من توضيح، تركت ما تم طرحه حين الإلقاء، من الملاحظة على تغير المفاهيم، والاستشهاد بأن ذلك يوافق مقالة القائلين بنظرية القبض والبسط التي رد عليها هو(حفظه الله) في بعض كتبه، كما أن تغير المفاهيم وتبدلها يغاير ما ذكره في بعض كتبه كمنطق القرآن، والتوحيد، لعدم وجود الحاجة إليه.
[17] سورة الحج الآية رقم 27.
[18] سورة يوسف الآية 19.
[19] سورة الأنفال الآية رقم 60.
[20] سورة النساء الآية رقم 141.