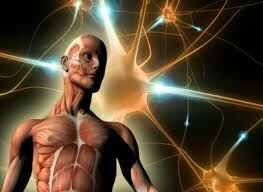كلمة الجمعة: انسجام النظم التكويني والتشريعي
يثير بعض الحداثيـين والمثقفين شبهاً حول التشريعات الإسلامية، توحي بعدم الانسجام بين النظم التكويني والنظم التشريعي، وأن الشارع المقدس عندما جعل تلك التشريعات، لم يرعَ فيها الناحية التكوينية، ويذكرون لذلك جملة من الأمثلة:
منها: تكليف الفتاة في سن التاسعة، فإن هذا لا ينسجم مع طبيعتها التكوينية، لأن توجيه الخطابات الشرعية لها بلزوم الصلاة عليها في الأوقات الخمسة، وكذا جعل الصوم عليها، لا يتوافق وطبيعة تكوينها الجسماني، فإن من الصعوبة بمكان أن يطلب من فتاة صغيرة لم يتعدّ عمرها التاسعة أن تقوم من فراشها عند الفجر لتؤدي صلاة الفجر في وقتها، وإلا كانت مرتكبة لحرام بتركها أداء الصلاة في وقتها، أو يطلب منها صيام ستة عشر ساعة أو أزيد في الصيف القائض شديد الحرارة، أداء للصوم الواجب عليها وهي صغيرة هزيلة البنية ضعيفة الجسد.
ومنها: منع الزوجة من تعديد الأزواج، مع إباحة ذلك للرجل، فليس للزوجة أن تعدد الأزواج بأن تتزوج بأكثر من زوج، ويسمح للرجل بذلك، فكما أن الطبيعة التكوينية للرجل تخول له أن يعدد الزوجات، فإن تلك الطبيعة التكوينية موجودة عند المرأة أيضاً.
ومنها: الضرائب المالية المجعولة على الأغنياء في أموالهم للفقراء، فإن هذا لا ينسجم مع المجهود البدني والفكري الذي يبذله الأغنياء لتحصيل المال، فكيف يأخذه الفقراء بعد ذلك.
وليست هذه الاعتراضات وغيرها وليدة اليوم، وإنما يجتر هؤلاء المثيرون لها ما كان يذكره اللادينيون من قبل ضد الإسلام، ويسعون لتشويه صورته من خلال هذه الأمور.
وعلى أي حال، سواء كانت هذه الشبه صادرة عن هؤلاء، أم عن هؤلاء، فإن المهم هو بيان كيفية التصدي لها والإجابة عليها، والتأكيد على وجود تمام الانسجام بين النظم التكويني والنظم التشريعي، وأنه لا اختلاف بينهما. وهذا يستدعي أن يكون الحديث أولاً عن بيان النظم التكويني، ثم التعرض للكلام حول النظم التشريعي، وبعد ذلك الإشارة لتمام الانسجام بينهما.
النظم في عالم التكوين:
لا يختلف اثنان في خضوع هذا النظام الكوني الذي نشهد دورته في كل يوم وليلة من أصغر ذراته إلى أعم مجراته إلى قوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته، وترعى الروابط بين أجزائه، وقد كشفت عن ذلك العلوم الحديثة.
ومثل ذلك الكائنات التي تحيا فيه فإنها تعيش النظام الدقيق في أعضائها وخلاياها وتفاعلها مع محيطها، بما يضمن بقاءها وتكاملها. وهذا ما يعرف ببرهان النظم، وهو أحد الأدلة التي يستند إليها في إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى، مضافاً إلى وحدانيته، وقد كانت نشأت الدليل المذكور جراء ما لاحظه المتكلمون من دقة النظم في عالم التكوين.
ويقوم البرهان المذكور على أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر، وعلى هذا فإن دلالة الأثر على المؤثر تقوم على مقدمتين:
الأولى: قانون العلية: وهو أصل عقلي بديهي، يفيد أنه يستحيل عند الوجدان والعقل أن يتحقق شيء من دون علة أو سبب، فوجود الأثر دال على وجود المؤثر، فكل ما في الكون من سنن وقوانين لا ينفك عن علة توجده، كدلالة المعلول على علته، ودلالة الآية على صاحبها.
الثانية: إن دلالة الأثر لا تنحصر في الهداية إلى وجود المؤثر، بل إنها تفيد دلالة أخرى، وهي الكشف عن خصوصيات المؤثر من عقله وعلمه، وشعوره وغير ذلك.
فالبناء المتقن المحكم الرائع المظهر والترتيب، يكشف عن أمرين:
1-وجود مهندس قد خططه، وبناءً قد بناه.
2-علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا البرهان في بعض آياته، فقال سبحانه:- (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأٍرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون)[1].
النظم في عالم التشريع:
حتى يتسنى لنا الإحاطة بالنظم في عالم التشريع، لابد من عرضه مع التشريعات والقوانين الوضعية، توضيح ذلك:
يوجد في الحياة البشرية نوعان من القوانين والتشريعات المجعولة للإنسان:
الأول: القوانين الإلهية، وهو ما يكون مصدره الباري سبحانه وتعالى، وتكون الغاية من وضعه الحفاظ على المصالح البشرية.
الثاني: القوانين الوضعية، وهي القوانين التي يجعلها العنصر البشري، وغايته منها تنظيم الأوضاع العامة في الحياة البشرية. مثل قوانين السير التي تجعلها هيئات المرور، وقوانين الملكية، وأنظمة العمل والشغل، وغير ذلك.
فوارق النظم التشريعية عن الوضعية:
وتمتاز النظم الإلهية والقوانين المجعولة من قبل السماء، عن الأنظمة الوضعية في جوانب متعددة أوجبت التعبد بها، نشير إلى بعضها:
منها: البعد التربوي الذي تنطوي عليه القوانين الإلهية، دون القوانين الوضعية، ففي الجريمة مثلاً، ليس هناك من غاية للأنظمة الوضعية إلا معاقبة المجرم، من دون أن يكون هدف آخر وراء ذلك، ولهذا لا نجد تلك القوانين تعالج حالة الجريمة الموجودة عنده، لتجتثها من جذورها، بل على العكس تبقى جذورها موجودة، ولذا من الممكن جداً أن يعمد إلى تكرار جريمته مرة أخرى.
وهذا بخلاف القانون السماوي، فإن الغاية الأساسية التي جعلت من أجلها هي تربية المجرم، والعمد إلى إصلاحه، ليكون فرداً صالحاً في المجتمع. ولهذا نجدها تركز على أن لا يعود المجرم إلى تكرار جريمته مرة أخرى.
ومنها: البعد الشمولي للأمور النفسية والمادية، ذلك أن القوانين الوضعية تحصر دائرة مسؤوليتها في خصوص الأمور المادية التي تقع على الفرد بصورة مباشرة، كالضرب، والقتل، والسرقة، وما شابه ذلك. ولا ترتبط بما يقع عليه بصورة غير مباشرة، كالغيبة والنميمة والكذب والسباب والشتم، وما شابه. وهذا بخلافه في القوانين السماوية، فإنها كما تعالج ما يقع على الإنسان بصورة مباشرة، تضمنت عقوبات وعلاجات لما يقع عليه بصورة غير مباشرة أيضاً، وهكذا.
ومنها: انسجامها بعضها مع بعض بحيث تكون منظومة واحد، فلا ينافي حكم فيها حكماً آخر، وهذا بخلافه في القوانين الوضعية، فإن بعض الدول تضع قوانين معينة لفعل ما، إلا أنها ترتب آثاراً سلبية عليه، فهي تجيز تناول الكحول والمشروبات الروحية، التي توجب ذهاب العقل وفقده، فلو صدر منه شيء حال ذهاب عقله، تعمد إلى معاقبته، وهذا يؤكد عدم وجود الانسجام بين قانون الجريمة، وإباحية تناول المشروب الروحي، لأن المفروض أنه ما دام يسوغ له تناوله، فلا يرتب على ما يصدر منه من فعل أي أثر، لكونه بلا عقل.
وهذا بخلاف التشريعات والقوانين السماوية، فإننا لا نجد منافاة بين أي جعل وتشريع قانوني، وبين القانون الآخر، فقد أوجب سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة، كما سوغ لها حرية العمل والمشاركة فيه، إلا أن تسويغه عملها قد قيده بشروط وضوابط تنسجم تماماً مع وضعه قانون الحجاب.
وكذا أوجد الشارع المقدس علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وجعل من ضمن القوانين المرتبطة به قانون النفقة، إلا أن ذلك لم يكن ليؤثر على نفقة النفس، بل جعل نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة.
والحاصل، إن المتابع للقوانين والتشريعات الإلهية يرى أن بينها تمام الانسجام والترابط، فلا يقف الإنسان على وجود قانون ينافي قانون آخر.
وقد أشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى:- (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)[2].
منشأ النظم في عالم التشريع:
وقد يخطر إلى الأذهان سؤال، عن منشأ هذا النظم في عالم التشريع، ودقته بحيث تميزه على عالم الوضع، وحتى أصبحت القوانين السماوية أحكم من القوانين الوضعية، كما سمعت؟
وجواب ذلك يعود إلى مصدر القوانين السماوية، والذي تصدر عنه، فإنها قد صدرت عن واضع وجاعل يتصف بصفتين، لا يملكها الجاعل والواضع في القوانين الوضعية، والصفتان هما:
الأولى: العلم والإحاطة:
فإن الواضع الإلهي، على علم دراية وإحاطة بكل الحيثيات والجزئيات والدقائق، لأنه الخالق لهذا الكون كله، والخالق لما فيه، وما ينطوي عليه من موجودات، فهو عندما يجعل قانوناً ويشرع نظاماً، يجعله من خلال ما له من إحاطة وخبرة بكل ما في هذه الموجودات من حيثيات متعلقة بالتشريع وموضوعه.
الثانية: الحكمة:
والمقصود بها في المقام أن يكون للفعل الصادر من الواضع والمشرع غرضاً سامياً يسعى إلى تحقيقه، وليست غايته أمراً عبثياً، وهذا يعني أن المشرع المتصدي لمثل هكذا أمر يستحيل أن يصدر منه فعل عبثي، بل لابد وأن تكون جميع القوانين المجعولة من قبله موضوعة لغاية سامية ترتبط بمخلوقاته.
الانسجام بين النظم التكويني والتشريعي:
ومن خلال ما تقدم، يتضح وجود نظام يحكم على عالم التكوين، كما أن هناك نظاماً آخر يحكم على عالم التشريع، ويبقى الكلام في مدى وجود الانسجام بين هذين النظامين، بحيث هل يتصور وجود تهافت وتعارض بينهما، بأن يفيد نظام التكوين شيئاً، ويفيد نظام التشريع شيئاً آخر، بحيث لا يكونا منسجمين مع بعضهما البعض، أو لا؟
إن الرجوع للدواعي التي تدعو للتعبد بالنظم التشريعية السماوية الصادرة عن الله سبحانه وتعالى، من خلال وجود الإحاطة المطلقة بالموجود البشري، والحكمة الداعية لجعل التكاليف، يستدعي البناء على لزوم الانسجام بين النظم التشريعية والنظم التكوينية، لأن الموجد لهما واحد، وهو المحيط بكل ما فيهما من دقائق وحيثيات وجزئيات، كما أنه الحكيم في صنعه وتدبيره وخلقه، وهذا يستوجب الانسجام بينهما كما قلنا.
إلا أنك قد سمعت في مطلع البحث بعض الإثارات التي تشير إلى نفي وجود هذا الانسجام بنيهما، من خلال استعراض بعض الموارد القانونية في النظام التشريعي، والتي يدعى عدم انسجامها مع القوانين التكوينية.
ومع أننا نعتقد أن الأحكام الشرعية أحكام تعبدية محضة خاضعة لقانون المصالح والمفاسد، فأمره سبحانه وتعالى بشيء يعود لوجود مصلحة فيه، كما أن نهيه عن شيء يعود لوجود مفسدة فيه، ونحن نعلم عجز العقل البشري غالباً عن إدراك تلك المصالح والمفاسد، وهذا ينفي وجود الحاجة إلى عملية التبرير، ومحاولة إيجاد ما يوجب القبول بها، بل يعود الأمر إلى الجانب التعبدي المحض.
مضافاً إلى سهولة الشريعة وسماحتها، فإنه لا يتصور أن يكلف فرداً أمراً لا يطيقه، كيف وقد تضمنت الشريعة رفع التكليف في الموارد التي لا يكون المكلف قادراً على الامتثال والاتيان، بل منعت من التكليف بغير المقدور. وهذا يستوجب وجود تمام الانسجام بين النظم التكويني والنظم التشريعي.
إلا أنه رغبة في تقريب القبول بهذه الأحكام، يعمد إلى ذكر بعض الحِكمِ المتصورة في جعلها، وليس ما ذكرناه بياناً عللاً للأحكام الشرعية، يدور الحكم مدارها وجوداً وعدما، ومن الواضح أن مقتضى كون المذكور بياناً للحكم، أنها قد تصيب الغرض، وتصلح لبيان المطلوب، وقد لا تكون كذلك، إذ غايتها تقريب الفكرة، وتوصيل القبول بالحكم الشرعي كما لا يخفى.
منها: أسبقة الأنثى في التكليف:
من المعروف فقهياً عند علماءنا أسبقة تكليف الأنثى، فإنها تبلغ بإكمال تسع سنوات هلالية وبدخولها في العاشر كما هو المشهور، وهذا يعني توجه التكاليف الإلهية إليها قبل الذكر الذي لا يكون بلوغه بالسن إلا بعد إكماله خمس عشرة سنة هلالية، ودخوله في السنة السادسة عشر، وهذا لا ينسجم مع التكوين البدني للأنثى، فإنه من غير المتصور أن تقدر فتاة صغيرة في سن العاشرة على القيام بهذه التكاليف الإلزامية، وتكون مستحقة للعقوبة على مخالفتها، فإن هذا يشير إلى عدم الانسجام بين النظم التكويني المتمثل في القدرة البدنية للفتاة، وبين النظم التشريعي، كما لا يخفى.
وملاحظة الخصائص والمميزات التي جعلها الباري سبحانه وتعالى في كل واحد من الرجل والمرأة، سواء في التكوين الجسدي، أم النفسي، بحيث أصبح كل منهما يكمل الآخر، ولم يجعلهما متشابهين لأن ذلك يمنع من كمال المجتمع، يوضح السبب في تقدم الفتاة في التكليف على الصبي، فإن القابلية الموجودة عندها تختلف عن القابلية الموجودة عنده، بحيث أصبحت في هذه المرحلة جديرة بالخطاب، بينما هو بعدُ لم يبلغ ذلك، وذلك بسبب ما أودعه تعالى فيها من قدرات وقابليات.
وقد راعت الشريعة السمحاء حال الفتاة كبقية المكلفين، فمع أنه خاطبها الباري سبحانه تعالى بالتكاليف الشرعية، إلا أنه قد لحظ عنصر القدرة في الامتثال، فيسقط التكليف عنها حال فقدانها، وتنتقل للإتيان بتكليف بديل، فلو لم تقدر الفتاة على الصوم مثلاً، وجب عليها دفع الفدية عوضاً عنه. وهكذا.
ومع أخذ شرطية القدرة في التكليف، يتضح تمامية ما ذكرناه من وجود خصائص تمتاز بها الفتاة على الذكر في التكويني الجسدي والنفسي جعلتها جديرة بحمل الأمانة الإلهية أعني التكليف أسبق منه.
ومنها: حرمة التعدد على النساء دون الرجال:
فإن الوارد في الشريعة السمحاء أنه يحق للرجل أن يتـزوج أربعاً من النساء، وليس للمرأة إلا الزواج برجل واحد، وهذا يشير إلى عدم الانسجام بينهما.
وينبغي قبل الجواب عن الشبهة المذكورة الإشارة إلى أن إمضاء الإسلام لظاهرة التعدد للرجل، لم تترك دون حدود وضوابط، فلا يتصور أحد أن الشارع المقدس قد أعطى حق التعدد للرجل مفتوحاً على مصراعيه، بل قد وضع لذلك أسساً وقواعد تحد من سوء استخدام هذا الإمضاء.
وقبل أن نشير إلى الجواب الأساس عن الإشكال المذكور، نشير إلى جواب جانبي يصلح ولو في الجملة علاجاً عن هذا الإشكال، وهو عين ما تقدم ذكره جواباً عن الإشكال السابق، فيقال: إن التكوين الجسدي والنفسي لكل من الرجل والمرأة أعطى أسبقية للفتاة في التكليف على الذكر، كذلك يقرر في المقام بأن التكوين الجسدي للرجل يعطيه حق التعدد دون المرأة، فإن الرجل وبمقتضى تكوينه لا يقوى على مقاومة رغبته الملحة في ممارسة العلاقة الطبيعية، فلا يكفيه في تلبية رغبته زوجة واحدة، سواء كان منشأ ذلك ضعف الزوجة، لإصابتها بمرض أو غير ذلك، أو شدة الطاقة المودعة فيه. مضافاً إلى بعض الأمور الخارجة عن الإرادة مثل جمال المرأة ودلالها، وهذا ما قد تفتقر إليه الزوجة الأولى، فيبحث الزوج عنه في الزوجة الثانية.
وأما الجواب الأساس للشبهة المذكورة، فيتضح بمعرفة منشأها، والتأمل يفيد أنها قد نشأت نتيجة وجود خلط في مفهوم العدالة عند المستشكل، فإنه يعتقد أنها تفسر دائماً بالمساواة، وليس الأمر كذلك، فإن العدل كما يكون بالمساواة، فإنه يكون أيضاً بوضع كل شيء في محله وموضعه، ومنها إعطاء كل ذي حق حقه.
ولا يخفى أن تحديد الحقوق يقوم على ملاحظة الحاجات التي تقتضيها طبيعة كل مخلوق ومعرفة الظروف الموضوعية المحيطة به والملاكات الواقعية. فمجرد اشتراك بعض المخلوقات في عنصر الإنسانية، لا يعني أن تكون الحقوق الثابتة لهم جميعاً على حد سواء، فالمرأة والرجل والطفل، يشتركون جميعاً في الإنسانية، إلا أن حقوق كل واحد منهم تختلف عن الآخر، فليس من العدل أن تكون الحقوق الثابتة للرجل بعينها ثابتة للطفل، أو العكس، فإن القول بذلك ينافي العدالة، مع أنه وفقاً لإشكال المستشكل يلزم ذلك.
وعليه، فإن مقتضى العدالة أن يعطى كل واحد من الموجودات ما يحتاج إليه، ولا يخفى أن المرأة لا تحتاج إلى تعدد الرجال، فإن طبيعتها التكوينية والنفسية تقتضي الاكتفاء برجل واحد، وهذا دون الرجل، فإن طبيعته التكوينية والنفسية تقتضي بعدم اكتفائه بذلك، من هنا حكمت الشريعة بمشروعية التعدد للرجل، دون المرأة.
ومنها: دفع الحقوق الشرعية:
ومن الإشكالات التي يثيرها هؤلاء إخراج الحقوق الشرعية، سواء الزكاة أم الخمس، من أموال الأغنياء ودفعها للفقراء، فإن هذا مشاركة منهم إليهم في أموالهم، مع أنهم لا يستحقون شيئاً من ذلك، فإن الأغنياء هم الذين بذلوا الجهد، وتعبوا من أجل الحصول عليها، فكيف يكون للفقراء نصيب فيها.
ويغفل هؤلاء عن واحدة من الغايات التي من أجلها شرّع الإسلام الضرائب المالية على الأغنياء، وألزمهم دفعها للفقراء، وهي التكافل الاجتماعي، وهي تمثل البعد الأخلاقي في قانون الإسلام الاقتصادي. فعندما يشعر الغني أن عليه مسؤولية يطالب القيام بها، وأن ما تحت يده ليس ملكاً له على نحو الاستقلال، وإنما يشاركه فيه غيره، على نحو التعاون والتكافل، والإحساس بالآخر، فإن ذلك يوجد حالة من التواد والتراحم بين أفراد المجتمع، ويمنع من أن ينظر أحدهم للآخر نظرة إيذاء، أو نظرة رغبة في زوال نعمة، منه أو حلول نقمة به.