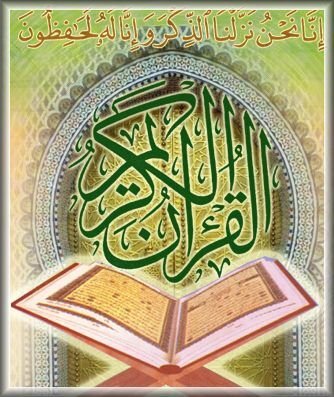القرآن، مصدره وثقافة عصره(2)
قال تعالى: – (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ).
تعرضنا في البحث الماضي إلى شبهتين تثاران ضد القرآن الكريم:
الأولى: دعوى وجود مصدر قد اعتمد عليه النبي الأكرم (ص) في تأليف القرآن الكريم.
الثانية: الالتزام بتأثر القرآن الكريم بثقافة عصره.
وقد استند أصحاب الشبهة الأولى إلى أدلة ثلاث:
١- شخصية ورقة بن نوفل.
٢- التطابق بين مضامين القرآن والكتب السماوية السابقة.
٣- اشتمال القرآن على قصص مأخوذة من كتب بشرية.
وذكر أصحاب الشبهة الثانية شواهد لمدعاهم، مثل غلبة العنصر الذكوري في الأحكام الشرعية كما كان ذلك في المجتمع الجاهلي.
وقلنا إن غاية الشبهتين إثبات صفة البشرية للقرآن الكريم ونفي الصفة السماوية عنه، وأجبنا عن ذلك من خلال الحديث عن النظم القرآني، وبيان أنه وحي من الله كما هو عليه الآن وبما تضمنه من علوم ومعارف.
بعد هذا نتحدث ضمن محورين:
الأول: تأصيل لبعض المفاهيم الدخيلة في الجواب:
سوف نشير لبعض المفاهيم النافعة في رفع الشبهتين المتقدمتين فهنا نقاط:
النقطة الأولى أمية النبي(ص):
أجمع المؤرخون على وصف رسول الله (ص) بالأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب قبل بعثته الشريفة، فهو لم يأخذ العلم عن أي معلم ولم يتعلم القراءة والكتابة عند أحد، وقد أكد القرآن الكريم على هذه الصفة في بعض آياته، مثل الآية التي افتتحنا بها المقام:- (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ). والاستناد لهذه الآية الشريفة أفضل من الاستناد إلى الآيات التي وصفته (ص) بالأمية مثل قوله تعالى: – (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي)، لعدم كون المقصود بالأمي فيها الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل يقصد به شيء آخر كما سوف نشير لذلك بعد قليل.
ومع التمسك بآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب لا يصغى للقول بأنه (ص) كان يقرأ ويكتب قبل البعثة الشريفة، كما أنه لا يوجد ما يسنده من دليل إلا روايتين لا تصلحان لإثبات ذلك.
وعليه يتعين أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب قبل البعثة الشريفة، بل حتى بعدها لم يكن قارئاً ولا كاتباً، نعم قد يستفاد من بعض النصوص أنه كان يقرأ ولا يكتب.
وإنما قدمنا الاستدلال بالآية التي افتتحنا بها المقام، لأن الأمي في الآية الأخرى بمعنى الأصل، وعليه لا معنى لحمله على المعنى الاصطلاحي للأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب.
وعلى أي حال تعد أمية النبي (ص) عنصراً من عناصر إعجاز القرآن الكريم وسبباً من أسباب حقانية دعوته ورسالته.
ولا ينحصر دليل أميته (ص) في خصوص القرآن، بل يمكن التمسك لذلك بالتاريخ أيضاً، فإن المؤرخين وكتب السير الذين رصدوا أغلب المسائل الجزئية والدقيقة في حياته (ص)لم يشيروا من قريب أو بعيد إلى تعلم النبي (ص) ولم يذكروا أسماء الذين تولوا تعليمه والمكان الذي تعلم فيه والمدة الزمنية التي قضاها في التعليم أبداً.
ولا يتوهم أن عدم أميته (ص) كانت قضية عادية، بل إن معرفة المجتمع المكي به، وأن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة أشخاصاً محدودين معدودين ذكرت أسمائهم في التاريخ توجب تسليط الضوء عليه (ص) لو كان يقرأ ويكتب وكان التاريخ يسجل ذلك. وقد اعترف بعض المستشرقين بذلك.
ومع كون النبي (ص) أمياً كما عرفت، لا تتم الشبهتان المتقدمتان، نعم قد يعترض على أميته(ص) بإشكالات نشير لبعضها:
الأول: إن أميته (ص) لا تناسب الموقع الاجتماعي لعمه أبي طالب: فقد كان أبو طالب (ع) يتولى زعامة قريش وقد تعلم ولداه جعفر وعلي القراءة والكتابة فكيف لم يتعلم النبي (ص) وهو الذي كان يولي رسول الله (ص) أهمية لا تقل عن اهتمامه بأولاده.
ونجيب: أولاً: ان دعوى تعلم جعفر وعلي (ع) ليس عليها برهان، فإنه لم يذكر في أسماء من يقرأ ويكتب اسم جعفر، وأما علي(ع) الذي ذكر اسمه ضمنهم إلا أنه لم يعرف كيف تحقق له ذلك، ولعل تعليمه كان بواسطة رسول الله (ص) لأنه ربيبه. والحاصل لم يثبت تعليم أبي طالب لأولاده.
ثانياً: إن أمية النبي (ص) تعدّ من الألطاف الإلهية المدبرة، فإن عدم تعلم النبي (ص) على يد معلم يقطع الطريق على من يفكر في اتهامه باقتباس الوحي والإسلام من الأديان الأخرى.
الإشكال الثاني: التمسك ببعض الآيات مثل قوله تعالى: – (ويعلمهم الكتاب والحكمة) فإنه لا يتصور أن يتصدى لتعليم الآخرين من لا يعرف القراءة والكتابة.
ويجاب: بأن التعليم الصادر منه (ص) كان من خلال إلقاء ما حفظه من الوحي، فيقوم بالوعظ والتعليم من هذا الباب مع أن مقتضى اتصال النبي(ص) بعالم الغيب وثبوت منصب النبوة له يكفيه في القيام بعملية التعليم.
النقطة الثانية: وحدة المصدر:
نعتقد نحن المسلمين باتحاد الشرائع الإلهية جميعها ورجوعها إلى مصدر واحد يجمعها كلها كلمة التوحيد والإخلاص في العمل الصالح والتحلي بمكارم الأخلاق، قال تعالى: – (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه).
وجميع الأحكام والتكاليف التي تضمنتها الشرائع السماوية هدفها غرض واحد وهو كمال الإنسان، ولذلك قال تعالى: – (إن الدين عند الله الإسلام) فمن آدم(ع) حتى النبي محمد (ص) دين واحد وهو الإسلام يعني التسليم والإخلاص لله في عبادته، وهذا ما أكده سبحانه بقوله تعالى:- (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه.
ومن الطبيعي بعد اتحاد المصدر وهو الوحي تجد تشابهاً بين الأديان السماوية وتطابقاً فيها.
إن قلت: إن هذا لا يخرج عن كونه دعوى يقابلها دعوى أخرى وهي أن يكون القرآن متخذاً من الآخرين.
قلت: إن هناك شواهد تثبت ما ذكرناه وتنفي الاحتمال الآخر، وهي:
١- نص القرآن صراحة في كونه موحى من قبل الله تعالى إلى نبي الإسلام وحياً مباشرياً نزل عليه ليكون للعالمين نذيراً.
٢- ما تضمنه القرآن من معارف قدمها للبشرية بحثاً وراء فلسفة الوجود ومعرفة الإنسان ذاته، لم يصل إليها الفكر البشري خلال تلك الفترة.
٣- التعاليم الراقية التي عرضها القرآن والتي لا تتجانس مع ضئالة الأساطير المسطرة في كتب العهدين.
ويؤكد ما ذكرناه، بل يدل عليه ما نعتقده في ناسخية الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة، فإنه وإن بنى بعض الأعلام على أن معنى الناسخية هو دفع جميع الأحكام الثابتة في الشريعة السابقة وتشريع أحكام جديدة، إلا أنه لا يساعده الدليل والصحيح أن هناك أحكاماً رئيسية تشترك فيها جميع الأديان السماوية لا يطالها التغيير والنسخ، وتجري بعض التعديلات والاضافات وهي بمثابة المكملات، وهذا هو الذي يساعد عليه الدليل كما في معتبر زرارة الوارد في الكافي، مضافاً للإشكالات المترتبة على القول الأول.
ومن خلال وحدة المصادر بين الأديان السماوية واشتراكها فيه وهو الوحي يظهر عدم تمامية الشبهة الأولى.
النقطة الثالثة: موقف أعداء الإسلام من القرآن الكريم:
عندما نراجع موقف أعداء الإسلام من القرآن الكريم نجدهم يذعنون له بالقبول والتسليم، ومع ذلك لم يتركوا وسيلة من الوسائل إلا واتهموا رسول الله (ص) بها، فلو كان القرآن مأخوذاً من أحد لكان أعداء الإسلام في ذلك العصر هم أول من يطرح هذا الأمر، خصوصاً وأن المكيين كانوا يتواصلون مع بعض أهل الكتب وقد أخذوا منهم بعض الأسئلة لطرحها على رسول الله (ص)، ما يعني اطلاعهم على القرآن، فلماذا لم يتهموا رسول الله في تلك الفترة، بأنه قد أقتبس من كتبهم، وأخذ عنها؟!.
وقد خلت صفحات التاريخ من الإشارة من قريب أو بعيد لارتباط رسول الله (ص) بأهل الكتاب. نعم ذكر ذلك في موردين:
١- في سفره مع عمه أبي طالب(ع) إلى الشام ولقائه بالراهب بحيرة وقد كان عندها صبياً.
٢- في مرحلة الشباب.
وكلا اللقاءين كان مختصراً لا يساعد على تلقي شريعة عيسى(ع)، والاحاطة بها ليقتبس منها.
المحور الثاني: مناقشة الشبهتين:
مع أنه قد اتضح من خلال ما تقدم عدم تمامية الشبهتين، لكن زيادة في الفائدة نجيب عن أدلتهما:
الشبهة الأولى وأدلتها ثلاثة:
أما الدليل الأول الذي استند له أصحابها، وهو وجود شخصية معلمة لرسول الله(ص)، وهو ورقة بن نوفل، فيجاب عنه:
أولاً: بالتشكيك في وجود شخصية في التاريخ بهذا الاسم, فإنه لا ذكر له في المصادر التاريخية إلا في خصوص قضية الوحي, وهي رواية ضعيفة سنداً, بل متنها مختلف.
ثانياً: بعد التسليم بوجوده, فإن المنقول أن وفاته كانت في السنه الثانية من البعثة, فإذا كان هو الذي يزود النبي محمد (ص) بالمعلومات يلزم أن تنقطع به السبل لوفاة المصدر, مع أن الثابت استمراره (ص) مدة عشرين سنة.
ثالثاً: أن كثيراً من الأمور المدعى اقتباسها مدنية, والمفروض وفاة ورقة قبل ذلك الوقت.
وأما الدليل الثاني، وهو المطابقة بين ما تضمنه القرآن الكريم، وما جاء في الشرائع السماوية السابقة كاليهودية مثلاً:
فيجاب عنه أولاً: بأنه قد عرفت أن المطابقة تعود لوحدة المصدر وهو الوحي, فكما أن سفر التكوين كتاب وحياني إلهي, كذلك القرآن الكريم.
ثانياً: إن العهد القديم لم يكن مترجماً للغة العربية في ذلك الوقت باعتراف المستشرقين أنفسهم, وكل ما كان موجوداً عند الرهبان من التوراة كان بغير العربية, وقد كانت أول ترجمة للتوراة إلى العربية في بدايات الخلافة العباسية.
ثالثاً: لنسلم أن محمداً (ص) قد أخذ ذلك ولو بالتعلم عند المطلعين على تلك الكتب فلماذا انحصر الأمر فيه, ولماذا لم يوجد أحد غيره قام بمثل هذا الأمر.
رابعاً: مع الاتفاق بين القرآن والعهدين في قصص الأنبياء, إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً بين القصص في القرآن وبقية الكتب السماوية كقصة خلق آدم, وطوفان نوح وغرق فرعون ونجاة قوم موسى. بل إن بعض قصص الأنبياء كهود وشعيب مثلاً لا وجود لها في التوراة.
ولابد من الالتفات إلى أن جملة من القصص القرآنية تحوي رداً على ما تضمنه الكتاب المقدس.
وأما الشبهة الثانية: وهي تأثر القرآن الكريم بثقافة عصره:
فسوف نقتصر على ذكر بعض الشواهد حذراً من الإطالة:
الأول: كونه باللغة العربية وهي لغة المكان الذي نزل فيه.
والجواب عن ذلك: إن منطق العقلاء يقرر أن المبعوث لقوم بأمر ما لابد وأن يكون متحدثاً بلغتهم حتى يمكنه إيصال ما يريد إيصاله إليهم, وهذا لا يعني تقييد الإله بهذا اللغة, وإنما قد وظف اللغة لتكون جسراً ينقل من خلاله المعارف والقيم.
وأما استعراض المفاهيم المعروفة عندهم فذلك حتى يمكنهم تصور الأمور المعروضة عليهم، فأنه لو أخبرهم بأشياء لا يعرفونها فمن الطبيعي لن يمكنهم تصورها.
الثاني: تأثر القرآن بثقافة عصره في أحكامه، وذلك باشتماله على جملة من الأحكام ذات البعد الذكوري كما سمعت عند عرض الشبهة. مضافاً إلى كونه متأثراً في بعض تشريعاته كالعبادات مثلاً بما كان موجوداً في الشرائع السابقة كالحج مثلاً.
والجواب عن ذلك بالإحاطة بالطريقة التي جاءت بها الشريعة المحمدية في تشريعاتها، فإن من الخطأ تصور أن الشريعة المحمدية جاءت من أجل تأسيس شيء جديد في كل مورد وشيء، بل الصحيح أن هناك أموراً أبقتها الشريعة السمحاء لم تعمد لتغيـيرها لأنها تتوافق والحاجة البشرية، كما أشرنا لذلك إجمالاً قبل قليل حال الإشارة إلى النسخ، وهو يؤكد ما قررناه من اتحاد المصدر فإن المشرع واحد، وهو الذي يعلم المصلحة فيعمد للإلغاء بالنسخ، أو الإبقاء.