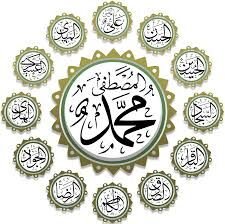الإمامة من أصول الدين
يختلف الإمامية عن المشهور من علماء المسلمين في عدّهم الإمامة مسألة كلامية، فيكون نصب الإمام وتعيـين الخليفة بعد النبي(ص) مسألة إلهية لا دخل للبشر فيها من قريب أو بعيد، بينما يبني مشهور علماء المسلمين على أنها مسألة فقهية، وليست عقدية، لأن نصب الإمام بيد أهل الحل والعقد من الناس. قال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة…ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات، بل من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ[1].
نعم قال أبو الفتح الأسروشني وهو أحد علماء المسلمين بكفر منكري إمامة أبي بكر[2]، الكاشف عن بناءه على أن الإمامة مسألة كلامية، وأنها من أصول الدين.
ومع بناء علماء الإمامية على أن الإمامة مسألة كلامية، إلا أنهم اختلفوا في عدّها أصلاً من أصول الدين، أو من أصول المذهب، فوجد قولان بينهم:
الإمامة أصل من أصول الدين:
القول الأول: وهو المنسوب إلى أكثر علماء الإمامية، من البناء على عدّ الإمامة واحداً من أصول الدين، لتكون أصول الدين أربعة بناءاً على عدم عدّ العدل منها، والالتـزام بعدّ المعاد منها، أو خمسة لو بني على عدّ العدل واحداً منها. وقد أدعي الإجماع على ذلك.
آثار القول الأول:
ويترتب على هذا القول مجموعة من الآثار:
منها: الالتـزام بأن منكر الإمامة خارج عن الدين، وهو كافر حقيقة، وهذا ما تضمنته كلمات بعض القائلين بهذا القول حيث صرحوا بذلك.
ومنها: الحكم بنجاسة المخالف، ولزوم الاجتناب عنه، لأنه كافر، وقد دل الدليل على نجاسة الكافر.
ومنها: بطلان ما صدر منهم من أعمال، فيستحقون العذاب في الآخرة، لأن الاعتقاد بالإمامة شرط صحة للعمل، ومع فقدانه يكون العمل الصادر غير صحيح.
ولنشر لبعض كلمات أصحاب هذا القول:
قال ابن نوبخت: دافعوا النص كفرة عند جهور أصحابنا[3].
ومقصوده من النص، النص على إمامة أمير المؤمنين(ع)، سواء من القرآن الكريم، أم من السنة الشريفة القطعية المتواترة.
وقال الصدوق(ره): يجب أن يُعتقد أن المنكر للإمام كالمنكر للنبوة، والمنكر للنبوة كالمنكر للتوحيد[4]. وعبارته(قده) صريحة في عدّ الإمامة أصلاً من أصول الدين، لأنه قد جعل إنكار الإمام الموجب لإنكار الإمامة بمثابة الإنكار للنبوة، والذي هو بمثابة الإنكار للتوحيد.
وحتى لو بني على إرجاع إنكار الإمام في كلامه(ره) إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين، فإن الظاهر البناء على عده(قده) الإمامة أصلاً من أصول الدين، لأنهم يستدلون على كون الإمامة أصلاً بأنها من ضروريات الدين.
وقال المفيد(قده): إن بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار[5]. ومقتضى تعليق قبول الأعمال على ولاية الأئمة الأطهار(ع)، يدل على أن الإمامة أصل من أصول الدين، لأن من لم يوالهم(ع)، لا يقبل له عمل يوم القيامة، ومقتضى عدم قبول شيء من أعماله عدم نيله الثواب من الله تعالى، فيكون مصيره إلى النار، بناءً على انحصار الجزاء في الجنة والنار.
وجاء عنه في كتابه أوائل المقالات عبارة أصرح وأوضح في الدلالة على التـزامه بأن الإمامة أصل من أصول الدين، قال(رض): واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال، مستحق للخلود في النار[6]. وقد تضمنت عبارته دعوى الإجماع من علماء الطائفة على عدّ الإمامة أصلاً من أصول الدين.
وقال الشريف الرضي(قده): النبوة والإمامة هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول[7].
وقال الشيخ الطوسي(قده): إن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار[8]. وجاء عنه(رض) في كتابه تلخيص الشافي: دفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد[9].
وقال ابن إدريس(قده): والمخالف لأهل الحق كافر عندنا، بلا خلاف بيننا[10]. ونفيه الخلاف بين علماء الإمامية مشير لكون المسألة إجماعية عندهم.
وقال العلامة(قده): ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم، لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد، فيكون ضرورياً، أي معلوم من دينه ضرورة، فجاحده يكون كمن يجحد وجوب الصلاة[11].
وقال(ره) في كتابه المنتهى: إن الإمامة من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوتها من النبي(ص)، ضرورة، والجاحد لها لا يكون مصدقاً للرسول في جميع ما جاء به، فيكون كافراً[12].
وقال العلامة المجلسي(ره): لا ريب في أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة والإذعان بها من جملة أصول الدين[13].
وقال صاحب الجواهر(قده): الأقوى طهارتهم في مثل هذه الأعصار، وإن كان عند ظهور صاحب الزمان(عج)، بأبي وأمي، يعاملهم معاملة الكفار، كما أن الله تعالى شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانهم[14].
وهذا هو مختار جملة من متأخري المتأخرين، لبنائهم على كفر المخالفين كفراً حقيقياً، كالسيد نور الله التستري، والمحقق اللاهيجي، والملا صالح المازندراني، وصاحب الحدائق، والشيخ الأعظم، والمحقق أغا رضا الهمداني، والملا السبزواري، وبعض الأعاظم، والسيد المرعشي النجفي، والشيخ محمد حسن المظفر[15]، وغيرهم.
ومع صراحة كلمات من سمعت في الالتزام بكون الإمامة أصلاً من أصول الدين، لا حاجة للبناء على تحديد مختار علماء الطائفة بما صنعه صاحب الحدائق(ره)، من استكشاف ذلك من خلال حكمهم بكفر المخالفين، حيث نص على أن قول أكثر القدماء بنجاسة المخالفين[16]. لأن المراجع لكلماتهم يقف على بنائهم على إسلامهم إسلاماً ظاهرياً، والعفو عن نجاستهم. نعم لو كان نظره(ره) إلى حكمهم بكفرهم واقعاً، ونجاستهم في الواقع، فإنه يصلح ما ذكره كاشفاً عن المدعى.
الإمامة من أصول المذهب:
القول الثاني: الالتـزام بكون الإمامة أصلاً من أصول المذهب، وليست أصلاً من أصول الدين. ويختلف هذا القول عن سابقه، في عدم الحكم بكفر من أنكرها، بل هم مسلمون إسلاماً حقيقياً، كما أن أعمالهم ليست باطلة، ولا يستحقون النار والعذاب في الآخرة، بل يكون مصيرهم مصير عامة الناس من حيث الجزاء، فمن كان منهم محسناً استحق الجنة، ومن كان مسيئاً، فمصيره النار. لأن الشرط الحقيقي للإسلام هو الاعتقاد بالتوحيد والنبوة. ولنشر لبعض كلمات أصحاب هذا القول:
قال بعض الأعلام(ره)[17]: إن على العامة أن يتذكروا دائماً أن اختلاف الفرقتين في الفروع، وأما في الأصول فلا اختلاف بينهم، بل هناك اتفاق بينهم في الفروع الضرورية، كالصلاة والصوم والحج، وغيرها.
وكلامه(ره)، ظاهر في عدم عدّه الإمامة من أصول الدين، لأنها مورد اختلاف بين الفرقتين، وليست مورد اتفاق. اللهم إلا أن يدعى أن الإمامة أيضاً مما اتفقت الفرقتان عليه، لأن الاختلاف الحاصل بينهم ليس في أصل الإمامة، لأن المسلمين أيضاً يقرّون بضرورة وجود الخليفة والإمام بعد رسول الله(ص). وإنما الخلاف بينهم في مصداقها الخارجي، وأنه أمير المؤمنين(ع)، أو غيره.
وقد ذكر بعض الأعيان(ره)، أن حقيقة الإسلام إنما هي التوحيد والنبوة، قال(قده): ماهية الإسلام ليس إلا الشهادة بالوحدانية والرسالة والاعتقاد بالمعاد، ولا يعتبر فيها سوى ذلك، سواء فيه الاعتقاد بالولاية وغيرها، فالإمامة من أصول المذهب لا الدين، وأما الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره، وينبغي أن يعدّ ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة المحقة[18].
ومثل ذلك قال الشيخ كاشف الغطاء(قده): الإسلام والإيمان مترادفان، ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان: التوحيد والنبوة، والمعاد-إلى أن قال-ولكن الشيعة زادوا الاعتقاد بالإمامة، فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه، فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص، لا أنه بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً معاذ الله[19].
وهذا هو مختار بعض الأساطين(قده)، قال: وأما النصوص، فالذي يظهر منها أنها في مقام إثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للإيمان، كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر والمؤمن[20].
ومن القائلين بذلك بعض كبار المفكرين الشيعة، حيث أكد على أن عدّ أصول الدين خمسة، إنما هي أصول للمذهب الشيعي، قال(قده): الحقيقة أن الأصول الخمسة المذكورة قد اختيرت بهذه الصورة، لأنها تحدد الأصول التي يجب الاعتقاد بها والإيمان من منظار إسلامي من جهة، ولكونها توضح الدين وتحدده من جهة أخرى، ويمتاز أصل الإمامة من وجهة نظر شيعية بالجهتين معاً، أي أنه داخل في نطاق الدين وموضح للدين ومحدد له[21].
وجاء عنه في موضع آخر: إن العدل والإمامة معاً علامة التشيع، من هنا يقال: إن أصول الدين الإسلامي ثلاثة، فيما أصول المذهب الشيعي اثنان، وهما: العدل والإمامة[22].
حقيقة أصول الدين:
ويحسن قبل استعراض أدلة كلا القولين الإشارة إلى المقصود من أصول الدين، لأنه يساعد كثيراً على تحديد أن الإمامة من أصول الدين أم من أصول المذهب حتى مع عدم ملاحظة أدلة كلا الطرفين:
لم يرد التعبير بأصول الدين في شيء من النصوص الدينية، فلم يشر له في القرآن الكريم، ولم تتضمنه النصوص المعصومية، وإنما هو معنى مستنبط منها.
والظاهر أن المقصود من المصطلح المذكور أركان العقيدة التي تتفق عليها سائر الأديان السماوية، بناءً على أن الدين السماوي الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين واحد، وهو الإسلام، ومنشأ تسمية تلك الأصول العقدية بهذا الاسم يعود إلى كونها تمثل الرؤية الكونية التي يبتني الدين عليها.
ووفقاً لما ذكر، سوف يكون المعيار فيها هو صدق انتماء الإنسان إلى الدين جراء الاعتقاد بها، فيكون مسلماً، لأنه ينتمي إلى الاسلام، وانتفاء الوصف المذكور عنه جراء فقدانه إياها، أو فقدانه واحداً منها، فلا يسمى مسلماً مثلاً لو أنكر النبوة، فضلاً عنه لن يسمى صاحب دين لو أنكر التوحيد.
ومقتضى ما ذكر سوف تنحصر أصول الدين في خصوص ثلاثة، وهي: التوحيد، والنبوة، والمعاد، أما التوحيد، فلأنه الأصل الذي يشير إلى المبدأ، بينما تشير النبوة إلى بيان التكاليف والوظائف، فهي تمثل سبيل الهداية الإلهية، وأما المعاد، فلأنه الأصل الذي يشير إلى المنتهى. وتعدّ هذه الأصول الثلاثة موضع وفاق بين سائر المذاهب الإسلامية. لأنه متى توفر الإنسان على الأصول الثلاثة المذكورة وصف بكونه مسلماً، وفقدانه واحداً منها موجب لسلب الوصف المذكور عنه.
ولما كان الاعتقاد بالعدل، وبالإمامة ليسا مقومين لتحقيق الانتماء للإسلام، الذي هو الدين، فلن يكونا من أركان العقيدة، ولن يكونا من أصول الدين. نعم هما متفرعان على بعض أصول الدين، إذ يتفرع العدل على التوحيد، وتتفرع الإمامة على النبوة، فهما فرعان لأصول الدين، ولا نعني بالفروع ما هو المألوف مما يذكر في الرسائل العملية للفقهاء من أحكام الفقه والذي يكون موضوعه الأحكام الشرعية، بل نقصد من ذلك ما ليس أصلاً من أصول الدين، ويكون مرتبطاً بالعقيدة وله علاقة بأصول الدين، نظير المعجزة والعصمة، إذ لا ريب أنهما ليسا من أصول الدين، بل هما من فروعه، ولكن لا يقصد من عدّهما من فروع الدين المعنى المألوف.
وهذا يعني أن هناك نحوين من فروع الدين:
الأول: ما يكون مرتبطاً بالأمور العقدية، وهو كل ما يلزم الاعتقاد به، وليس من أركان العقيدة وأصولها.
الثاني: ما يكون مرتبطاً بالشرعيات والأمور الشرعية.
أدلة القول الأول:
وقد تمسك القائلون بأن الإمامة أصل من أصول الدين بأدلة:
الأول: الإجماع:
حيث أدعي إجماع الطائفة واتفاقهم على كفر المخالفين، في كلمات كل من المفيد، والسيد المرتضي، وشيخ الطائفة(ره)[23].
ويكفي لمنع صلاحية الدليل المذكور للدلالة على المدعى احتمال المدركية فيه، المانع عن كشفه عن قول المعصوم(ع)، لما هو معلوم أن الإجماع عند أعلام الطائفة لا يعدّ دليلاً مستقلاً بنفسه، وإنما دليليته بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم(ع)، أو عن الارتكاز المتشرعي.
على أنه يمنع من القبول به أيضاً اختلاف مسالك من ادعو الإجماع في منشأ حجيته، إذ المعروف عن الشيخ الطوسي، وكذا السيد المرتضى(ره)، جعلهم مناط حجية الإجماع هو قاعدة اللطف، والمقرر في محله عدم تمامية الوجه المذكور.
أضف إلى ذلك أن المفروض أن المسألة كلامية، ولا يعول فيها على ما يكون ظناً أو يورثه، كالإجماع ولو كان محصلاً، بل لابد وأن يكون الدليل مفيداً للعلم، فتأمل.
الثاني: الكتاب:
وقد ذكر السيد المرعشي(ره) آيتين للاستدلال بهما على ذلك:
الأولى: آية إكمال الدين، وهي قوله تعالى:- (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)[24]، وتقريب دلالتها على المدعى وفقاً لما يستفاد من كلام السيد المرعشي(ره)[25] بملاحظة مقدمتين:
المقدمة الأولى: لقد أجمعت الشيعة الإمامية على أن الآية الشريفة نزلت يوم غدير خم بعد إعلان رسول الله(ص) ولاية أمير المؤمنين(ع)، وبيعته، وقد وافقهم على ذلك كبار الحفاظ والمحدثين والمفسرين من علماء المسلمين[26].
المقدمة الثانية: إن المستفاد من الآية الشريفة أن الدين الإسلامي كان ناقصاً قبل نزول الولاية، وإنما تم بنـزولها، فيثبت أن الإمامة من أصول الدين. والمقصود من الدين عبارة عن الأصول والأساسيات التي لا يتم الدين إلا بها، وفقدان واحد منها يجعله ناقصاً غير تام، ولا يكون محققاً لدين السماء الذي بعث به جميع الأنبياء(ع).
ومن المعلوم اشتراك الأنبياء(ع) جميعاً في الدين، كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:- (إن الدين عند الله الإسلام)، وإنما يختلفون في الشرائع التي جاءوا بها، فكان لكل واحد منهم شريعة تغاير الشريعة التي جاء بها نبي آخر، قال تعالى:- (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً).
ومع نص القرآن الكريم على إكمال الدين بالإمامة والخلافة، فهو يشير لكونه ناقصاً من دونها، ومعنى نقصانه فقدانه واحداً من أصوله وأساسياته، وهذا يدل على أنها أصل من أصول الدين.
وتمامية الاستدلال بها على المدعى فرع تمامية المقدمتين التي ابتنى الاستدلال عليهما:
المقدمة الأولى: سبب نزول الآية:
أما المقدمة الأولى، وهو تحديد سبب نزول الآية، فلا يخفى أن تماميتها تعتمد على توفر المقتضي وفقدان المانع، ونقصد بالمقتضي وجود ما يدل على أنها قد نزلت يوم واقعة غدير خم، وهو الذي نصب النبي الأكرم محمد(ص) فيها أمير المؤمنين(ع) ولياً للمؤمنين. وأما المانع، فهو عدم وجود ما يحول دون القبول بما تضمنه المقتضي، فهنا جانبان للبحث:
الأول: إحراز المقتضي.
الثاني: فقدان المانع.
احراز المقتضي:
أما بالنسبة للمقتضي، فإن البناء على احرازه فرع تحديد المقصود من اليوم الذي ورد ذكره في الآية الشريفة، وأنه خصوص يوم غدير خم، وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله(ص) أمير المؤمنين(ع) إماماً وخليفة من بعده، وعدم وجود محتملات أخرى فيه متصورة في كلمات القوم، مانعة من البناء على تعينه في يوم الغدير. وقد اشتملت كلمات المفسرين على ذكر محتملات في تحديد المقصود منه لابد من دفعها ليتعين اليوم في خصوص يوم الغدير:
منها: أنه زمان ظهور الإسلام، ببعثة سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد(ص)، ودعوته إلى التوحيد، ونبذ الأنداد.
ووفقاً لهذا القول سوف يكون معنى الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إليكم الإسلام، وأكمل لكم الدين، وأتم عليكم النعمة، ويأس الكفار من دينكم فلا تخافوهم بعد ذلك.
ولا يخفى أن هذا التفسير لليوم بما ذكر، مضافاً إلى أنه لا شاهد عليه من القرآن ولا من النصوص الشريفة، ولا القرائن الخارجية، يلزم منه البناء على أن للمسلمين قبل بعثة النبي محمد ومجيئه بالإسلام ديناً، كان المسلمون يخشون عليه من الكفار، وقد أيأس الله الكفار من ذلك بإكماله سبحانه وتعالى الدين وإتمامه النعمة على المسلمين، وهو باطل بالضرورة، فإنه لم يكن هناك للمسلمين دين قبل الإسلام، محل طمع الكفار، وأكمله الله تعالى، وأتم نعمته عليهم. على أن البناء على هذا اللازم خلاف ظاهر الآية الشريفة.
ومنها: أنه ما بعد فتح مكة، ذلك أن يوم فتح مكة هو اليوم الذي أبطل الله فيه كيد المشركين، وأذهب شوكتهم وهدم بنيانهم، وبالتالي انقطع رجاؤهم من النيل بدين المسلمين، وأصبح المسلمون لا يخافونهم لا على دينهم، ولا على أنفسهم.
وتمامية هذا القول تتوقف على حصول كمال الدين بعد فتح مكة، فيثبت عدم صدور تشريعات سماوية بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة لحين رحلة النبي محمد(ص) عن عالم الدنيا في السنة الحادية عشر، أما لو ثبت لدينا أن التشريعات السماوية لم تتوقف عقيب فتح مكة، بل استمرت لحين رحلة رسول الله(ص) من عالم الدنيا، أو قريب من ذلك التأريخ، فلا ريب أن هذا سوف يكون مانعاً من جعل اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين، وأتم النعمة، هو يوم فتح مكة، كما لا يخفى.
هذا والثابت تاريخياً أن التشريعات السماوية لم تتوقف بفتح مكة، بل استمرت إلى عودة رسول الله(ص) من حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة من الهجرة، فقد ورد أن سورة المائدة وهي سورة أحكام نزلت في آخر عهد رسول الله(ص) بالدنيا، وهذا يمنع من القبول بهذا التفسير.
على أن هناك أمراً آخر في البين، وهو أياس الكفار، إذ أن التاريخ يحدثنا عدم تحقق ذلك بمجرد فتح مكة، بل بقيت جملة من العادات السيئة، والشرائع الفاسدة بين الكفار، حتى بعث النبي(ص) من أبطلها.
ومنها: أن المقصود من اليوم هو ما بعد نزول سورة براءة من الزمان، فإنه بعد نزولها انبسط الإسلام على جزيرة العرب، وعفيت آثار الشرك، وماتت سنن الجاهلية، فما عاد المسلمون يخشون كيد أحد على الإسلام، وأبدلهم الله سبحانه بعد خوفهم أمناً.
ولا يخفى أن هذا التفسير لا يختلف عن سابقه، فيأتي ما قدمنا ذكره هناك، من أن لازمه انقطاع حبل التشريع السماوي بتبليغ سورة براءة في السنة التاسعة من الهجرة حتى يصح القول بأن الدين قد كمل، كما لا يخفى.
ومنها: أن المقصود من اليوم في الآية الشريفة هو يوم عرفة، وهذا هو التفسير المعروف بين أبناء المسلمين، وجاءت به عدة روايات.
وأول ما ينبغي أن ينقح في هذا القول ملاحظة الحدث الأول الذي تضمنه هذا اليوم، حيث تضمنت الآية الشريفة الإشارة إلى وقوع أربعة أحداث في هذا اليوم، أولها هو يأس الكفار من دين المسلمين، ولذا ينبغي معرفة الكفار الذين يأسوا من دين المسلمين، إذ فيهم احتمالات:
1-أن يكون المقصود من الكفار مشركي قريش، ومعنى يأسهم منه هو يأسهم من الظهور عليهم، حيث انتصر النبي(ص) عليهم.
2-أن يكون المقصود من الكفار مشركي العرب، فما عاد لهم القدرة على الظهور على الإسلام أيضاً.
3-أن يكون المقصود من الكفار هو جميع الكفار، فيشمل اليهود والنصارى والمجوس، وغيرهم، تمسكاً بإطلاق الآية الشريفة.
ولا ريب في أن الاحتمالين الأولين أجنبيـين عن المقام، ضرورة أن أولهما انتفى يوم فتح رسول الله(ص) مكة المكرمة، فآيس عندها كفار قريش، كما أن الثاني انتفى يوم بلغ أمير المؤمنين(ع) سورة براءة في السنة التاسعة، فحصل اليأس عند كفار الجزيرة العربية.
والثالث أجنبي عن مقامنا، لأن اليهود والنصارى والمجوس أساساً ما كانت لهم شوكة في الجزيرة العربية حتى يحصل عندهم اليأس، إذ هم من البداية آيسين من الظهور على المسلمين لما عرفت من عدم شوكتهم، فكيف يخبر الباري سبحانه وتعالى عن حصول يأس عندهم!.
على أننا لو رفعنا اليد عما ذكرنا، وجئنا لنتأمل بأن القرآن الكريم أخبر بأنه في ذلك اليوم قد أكمل الدين، وأتمّ النعمة، فما هو الفعل الذي حصل وصدر من رسول الله(ص) يوم عرفة في حجته بحيث قيل عنه بأنه قد كمل الدين، وقد تمت النعمة؟ ذكر القائلون بأن اليوم هو يوم عرفة عدة تأويلات للإجابة عن ذلك:
أحدها: أن يكون المقصود هو إكمال أمر الحج بحضور النبي(ص) بنفسه الشريفة، وتعليمه الناس تعليماً قولياً وعملياً في آن واحد.
وهذا وجه حسن، لكن إنما يثبت إكمالاً للحج، وليس إكمالاً للدين، إذ الدين ليس منحصراً في خصوص الحج كما هو واضح، ولو سلم هو إكمال الحج، فإنه يلزم منه مخالفة ظاهر الآية الشريفة، إذ الظاهر منها أن ما صدر في ذلك اليوم موجب لكمال الدين كله، وسبب لانقطاع رجاء الكفار في هذا الدين والنيل منه.
ثانيها: أن يقصد منه نزول ما تبقى من الأحكام المرتبطة بأمور الحلال والحرام في يوم عرفة، وعليه فلا حلال ولا حرام بعد ذلك اليوم، وبانتهاء ذلك حصل اليأس عند الكفار، وانقطع رجاؤهم عن هذا الدين.
ولا يخفى أنه تقدم عند مناقشة بعض الأقوال التفسيرية في تحديد المقصود من اليوم بيان عدم تمامية هذا المعنى، إذ الثابت تأريخياً نزول جملة من الأحكام الشرعية ذات الارتباط بالتحليل والتحريم بعد يوم عرفة، كحكم الربا على سبيل المثال.
وقد يعمق هذا الوجه بأن البيان كان بإيضاحها بصورة تفصيلية في هذا اليوم بعدما كانت معروضة بصورة مجملة في أول بعثة النبي الأكرم محمد(ص).
وجوابه واضح، يتضح مما تقدم، فلا حاجة للإعادة. على أنه لو كان القائل به يود التنظير للمقام بما ورد في التدريج في تحريم الخمر، قيل بمنع ذلك، كما لا يخفى، لأن آية التحريم التي هي محل البحث لم تأتِ بشيء إضافي على الآيات الأخرى التي تضمنت الحديث عن التحريم، فلا وجه لتصور التدريج أصلاً، ويتضح هذا من خلال الرجوع للآيات التي تضمنت بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة، الواردة في سورة البقرة، وسورة الأنعام، وسورة النحل. نعم اختلفت هذه الآية عن الآيات الأخرى في أنها تعرضت لبيان أفراد الميتة، وهذا بنفسه لا يعدّ اختلافاً يتصور فيه التدريج في تبليغ الحكم، حتى يقاس على مسألة تحريم الخمر.
ثالثها: أن يكون المقصود من إكمال الدين في ذلك اليوم، أعني يوم عرفة بتخليص بيت الله الحرام من رجس الوثنية، وبراثن الشرك، وإجلاء المشركين عنه، وخلوصه لعبادة الله وحده لا شريك له.
ويتضح الجواب عنه مما تقدم في الإجابة عن وجوه مضت، إذ أن هذا قد تحقق يوم فتح رسول الله(ص) مكة المكرمة.
رابعها: أن يكون المقصود هو سد باب التشريع، فيقصد من إكمال الدين يعني أن باب التشريع قد سدّ، فلم ينـزل حكم آخر بعد نزول هذه الآية الشريفة في يوم عرفة.
وهذا أيضاً كسوابقه من الوجه الإجابة عنه تقدمت في الإجابة عن ما تقدمه.
فتحصل إلى هنا أن شيئاً مما ذكر في كلمات مفسري القوم لبيان المقصود من اليوم، وتحديده لا ينهض في إثبات المراد، فيبقى المقصود منه غير واضح بناءً على ما ذكروه.
بيان المقصود من اليوم:
هذا ولابد لتحديد اليوم الذي حدثت فيه الأحداث الأربعة التي تضمنتها الآية الشريفة، من ملاحظة التالي:
أولاً: إن الكفار كانوا يتربصون الأمر والدوائر برسالة النبي محمد(ص)، وكانوا يمنون النفس بموت رسول الله(ص)، وهم القائلون أنه أبتر، فبموته ينقطع ذكره، وتنتهي رسالته، وهذا يستدعي أن يأس الكفار لابد وأن يكون من خلال وجود عقب أو خليفة يواصل الحفاظ على الرسالة المحمدية ويتولى صيانتها ورعايتها، بحيث يكون وجوده سبيلاً إلى تسرب اليأس لنفوس الكفار، لأن ما كانوا يرجونه لن يتحقق لهم أصلاً.
ثانياً: إن كمال الدين، إنما يكون بوجود شخصية تكون امتداداً للرسول محمد(ص) بحيث تتصدى لإدارة الشأن التشريعي للأمة من جهة، والشأن الإداري والسياسي من جهة أخرى، فتكون ممثلة لرسول الله(ص)، في كل شيء، وامتداداً حقيقياً له.
وبالجمع بين هذين الأمرين، يتحصل عندنا أن المقصود من اليوم هو اليوم الذي أقام فيه النبي(ص) شخصية تتولى خلافة الأمة من بعده، وعمد إلى نقل كافة الصلاحيات إليها، فما كانت من الصلاحيات الشرعية التي لرسول الله(ص) تم انتقالها لتلك الشخصية في ذلك اليوم.
وعندما نعود للتأريخ لنتعرف على اليوم الذي كمل فيه الدين، وتمت فيه النعمة، ويأس الكفار من الإسلام، نجد أنه ينحصر في خصوص يوم الغدير، يوم أقام رسول الله(ص) أمير المؤمنين علماً هادياً وخليفة من بعده، له كافة ما كان لرسول الله(ص) فانتقلت له الصلاحية الشرعية عدا الوحي، فإنه لا وحي بعد نبينا(ص)، فحل منصب الإمامة محل منصب النبوة في قيادة الأمة والقيام بكافة مسؤولياتها.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه النصوص الواردة في شأن نزول الآية الشريفة والمتضمنة أنها قد نزلت في غدير خم، وفي شأن نصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) خليفة وهادياً.
فقدان المانع:
وأما ما يتصور أن يكون مانعاً من التسليم بالمقتضي، هو ملاحظة سياق الآية محل البحث ذلك أنها قد وقعت في سياق الحديث عن مجموعة من الأحكام الفرعية الفقهية، حيث سبقها شيء، فقد قال تعالى:- (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق)، ولحقها شيء آخر، قال تعالى:- (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). ومن الواضح أن ما اشتمله الصدر والذيل إنما هو حكم تشريعي، فقد كان موضوع الصدر بيان محرمات الطعام، وجاء الذيل ليشير لبيان حكم المضطر من حيث جواز أكل ما حرم من الأطعمة، ومع البناء على حجية السياق القرآني، فإن مقتضى وحدته تمنع أن يكون موضوع الآية محل البحث هو الإمامة، بل يكون موضوعها حكماً شرعياً كما سبقها ولحقها، ما يجعلها أجنبية عن المقام[27].
وما ذكر يؤول لباً للتمسك بوحدة السياق، وبالتالي ما دامت الآية الشريفة واقعة في سياق الحديث عن حكم تشريعي، فمن الطبيعي أن ذلك سوف يمثل قرينة صارفة لها عن الظهور في أي أمر آخر يخالف هذا المعنى.
ولا يخفى أن التمسك بالسياق فرع توفر شروط ثلاثة:
الأول: الالتـزام بتوقيفية ترتيب الآيات القرآنية، بل ترتيب الجمل المتعددة في الآية الواحدة، وأن ذلك من الامور الوحيانية التي صدرت عن رسول الله(ص)، ولم يكن ذلك بفعل الصحابة من بعده، لأن الاحتجاج به لا يتم إلا إذا أحرز أن الآية واقعة في نفس السياق، أما لو كان متفرقاً في أزمنة مختلفة، فلن تبقى حجية للسياق.
الثاني: يعتبر في الاستناد إلى وحدة السياق إحراز الوحدة الموضوعية بين الآيات، فإن من يقرأ القرآن الكريم يعلم يقيناً أنه كثير الانتقال بين المواضيع المختلفة، سواءٌ في السورة الواحدة أم حتى في الآية الواحدة، والسياق لا يكون حجة إذا لم نحرز بأن الآيات تتحدث عن نفس الموضوع.
الثالث: لابد من أن يكون السياق سبباً لإحراز أن ما تضمنته الآية الشريفة يفيد عنواناً كلياً، وليس مشيراً إلى مصداق من مصاديق الآية الشريفة، وتفصيل ذلك يطلب من محله.
ومن الواضح جداً عدم توفر الشروط الثلاثة المعتبرة في حجية السياق، ليصلح أن يشكل قرينة مانعة من انعقاد ظهور الآية في المعنى المقصود، إذ يكفي انتفاء الشرط الثاني منها، بل الشرط الأول أيضاً على ما هو مقرر في محله.
إجابة أخرى عن المانع:
وقد اشتملت كلمات أعلام الطائفة ومفسريها على إجابات أخرى غير ما سمعت في دفع إشكال التمسك بسياق الآية الشريفة ليكون مانعاً من الدلالة على أن المقصود باليوم الذي وقع فيها هو يوم غدير خم، فمن ذلك ما تضمن التسليم بحجية السياق، والبناء على أن ترتيب الآيات القرآنية في الكتاب المجيد وحياني توقيفي، إلا أن المانع من البناء على حجية السياق في المورد يعود إلى عدم احراز نزول المقاطع الثلاثة في الآية الشريفة في وقت واحد ليكون السياق حجة عندها، خصوصاً ونحن نعلم أن القرآن الكريم قد نزل نجوماً مدة ثلاث وعشرين سنة، وكما كانت الآيات الشريفة تنزل متفرقة خلال تلك الفترة، فإن أجزاء الآيات أيضاً كانت تنزل متفرقة أيضاً. ومجرد وقوعها في سياق هذه الآية لا يعني أنها نازلة معها في آن واحد، إذ أن جعلها في هذا الموضع قد يكون لحكمة ومصلحة اقتضت ذلك، وكان ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم محمد(ص).
والحاصل، إن مجرد وقوع الآية الشريفة في سياق آية أو مقطع من آية لا يوجب رفع اليد عن ظهورها فيما هي ظاهرة فيه، استناداً إلى وحدة السياق، وذلك لا للتشكيك في أصل الكبرى، وإنما لعدم إحراز الصغرى في كل مورد مورد.
هذا وقد ذكر بعض أعلام المفسرين توجيهاً آخر لوقوع هذا المقطع القرآني في الآية الشريفة، حاصله: لقد جرت عادة القرآن الكريم أنه متى أراد بيان أمر من الأمور التي لها أهمية خاصة أدرجه في ضمن الآيات الكريمة لحكم متعددة، ويعتبر ذلك أسلوباً بلاغياً مستحسناً عند البلغاء والفصحاء.
وذكر شاهداً على صحة ما ذكر وقوع آية التطهير النازلة في أهل بيت العصمة والطهارة(ع) في سياق الحديث عن زوجات النبي(ص)، مع أن الموضوع مختلف، قال تعالى:- (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً)[28].
قال(ره): إن الآيات الشريفة نزلت في نساء النبي(ص)، إلا أن قوله تعالى:- (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس)، جملة معترضة ذات دلالة مستقلة لا تتوقف على بقية الآية الشريفة، تبين قضية مهمة، وهي عصمة أهل بيت النبي الذين قرن الله طاعتهم بطاعته.
وفي المقام، يدل صدر الآية الشريفة على حرمة الميتة وبقية محرمات الطعام، وذيلها يدل على حليتها حال الاضطرار والمخمصة، فمجموع الصدر والذيل له وحدة دلالية كاملة متناسقة لا تتوقف على شيء آخر، نظير قوله تعالى:- (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن الله غفور رحيم)[29]. فيكون قوله تعالى:- (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)، كلاماً معترضاً أقحم في الآية الكريمة، ولا تتوقف دلالة إحداهما على الأخرى، فكل واحد منهما له دلالته الخاصة ويـبينان أمرين، أحدهما محرمات الطعام، والثاني كمال هذا الدين وتمامه وظهوره على الشرك كله، وأنه لا مطمع لأعداء هذا الدين في زواله.
وجعل مؤيداً لما ذكره(ره) النصوص الواردة في سبب نزول الآية، إذ ذكر أن أغلبها على كثرتها، تخص قوله تعالى:- (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم)، دونما تعرض منها لصدر الآية المباركة، ولا لذيلها، مما يفيد نزولاً مستقلاً لهذا المقطع عن نزول الآية الشريفة، فيبقى عندها موجب وضعه في هذا الموضع، فلعله كان لحكمة من الحكم[30].
وختم كلامه(ره) بالإشارة إلى اعتراض لم يعرض لذكره، وإنما أجاب عنه، بأنه لا مجال للقول بأن هذا يتم لو قيل أن القرآن الكريم قد جمع من قبل الصحابة، ولم يكن بأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، أو لم يكن بأمر من رسول الله(ص)، وتحت إشرافه، فذكر بأنه لا فرق بين أن يكون الواضع لهذا المقطع في هذا المكان الباري سبحانه وتعالى، أم النبي محمد(ص) بأمر من الله تعالى، أو كتاب الوحي بأمر من رسول الله(ص)[31].
وقد اشتملت كلمات بعض الأساتذة(دام ظله) بياناً للحكمة التي دعت إلى وضع هذا المقطع القرآني في هذا الموقع، مع أنها أجنبية عنه، إذ يمكن تعليله بأن الموجب لوضع هذا المقطع في هذا الموقع غايته هو صيانة هذا الموضوع من أن تصل إليه يد التحريف أو الحذف أو التغيـير، والموجب لاتخاذ هكذا إجراء وقائي وجود الحساسية المفرطة عند جملة من الصحابة تجاه خلافة رسول الله(ص)، ومن يتولى هذا المنصب من بعده، ويتضح ذلك جلياً يوم حيل بين رسول الله(ص) وبين كتابته وصيته، حتى قال قائل القوم: إن النبي يهجر[32].
ومع حسن الجواب الثاني الصادر عن بعض أعلام التفسير(قده)، لأنه يشير حسب الظاهر إلى فقدان الشرط الثاني الذي تمت الإشارة إلى اعتباره في حجية السياق، وهو انتفاء الوحدة الموضوعية بين المقاطع الثلاثة في الآية الشريفة، المانع من التمسك بالسياق عندها لفقد شرط من شروط حجيته، إلا أن للمناقشة فيه مجالاً، نعرض عن ذكرها، ونكتفي بما قدمناه من الجواب عن إشكال المانع.
………………………….
[1] الاقتصاد في الاعتقاد ص 253.
[2] احقاق الحق ج 2 ص 307.
[3] نقل هذا صاحب الحدائق(ره) عن كتاب فص الياقوت، ج 5 ص 175.
[4] الهداية ص 6-7.
[5] المقنعة ص 32.
[6] أوائل المقالات ص 7.
[7] الرسائل للشريف الرضي ج 1 ص 166.
[8] حكاه عنه في الحدائق عن كتابه تهذيب الأحكام ج 5 ص 175.
[9] تلخيص الشافي ج 4 ص 131.
[10] حكاه عنه في الحدائق عن كتابه السرائر ج 5 ص 175.
[11] نقله عنه في الحدائق في شرحه لكتاب فص الياقوت ج 5 ص 175.
[12] المصدر السابق.
[13] بحار الأنوار ج 68 ص 334.
[14] جواهر الكلام ج 6 ص 56.
[15] إحقاق الحق وإزهاق الباطل ج 2 ص 286-294، كوهر مراد ص 467، شرح أصول الكافي نقلاً عن الحدائق ج 5 ص 176، الحدائق الناضرة ج 5ص 157، كتاب الطهارة ص 330 الطبع الحجري، كتاب الطهارة ص 564 الطبع الحجري، مجموعة رسائل ص 266، تنقيح العروة كتاب الطهارة ج 2 ص 82-87، التعليقات على إحقاق الحق ج 2 ص 494، دلائل الصدق ج 2 ص 10.
[16] الحدائق الناضرة ج 5 ص 175.
[17] نقصد به العلامة الطباطبائي(ره) صاحب الميزان.
[18] كتاب الطهارة ج 3 ص 322-323.
[19] أصل الشيعة وأصولها ص 101-104.
[20] مستمسك العروة ج 1 ص 394.
[21] آشنائي با علوم إسلامي، علم كلام درس 8:9، انتشارات اسلامي، قم سنة 1983 م، 1362 ش.
[22] العدل الإلهي ص 56، النبوة ص 35.
[23] أوائل المقالات ص 7، الانتصار ص 231-233، تلخيص الشافي ج 4 ص 131.
[24] سورة المائدة الآية رقم 3.
[25] إحقاق الحق ج 2 ص 297 في الحاشية.
[26] قد أشار لبعض كلماتهم العلامة الأميني(ره) في كتابه الغدير، فمن أراد الاطلاع يمكنه المراجعة. الغدير ج 1 ص 230-235.
[27] تلوح هذه الدعوى من كلمات الألوسي في تفسيره روح المعاني.
[28] سورة الأحزاب الآية رقم 32-34.
[29] سورة البقرة الآية رقم 173.
[30] الميزان في تفسير القرآن ج 3 ص 137، مواهب الرحمن ج 10 ص 341.
[31] المصدر السابق.
[32] الأمثل في تفسير القرآن المنـزل ج 3 ص 531.